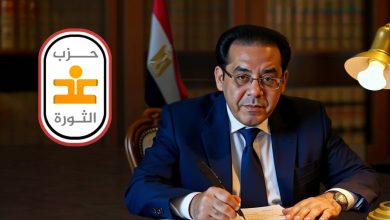عرب الشرق الأوسط هم الحلقة الأضعف فيه، رغم أنهم قلب الإقليم والقطاع الأكبر من سكانه ومن مساحته ومن ثرواته ومن مواقعه ذات القيمة الاستراتيجية، انظر من أعلى أو رأسياً، تجد العرب هم أكثر حلقات الشرق الأوسط خضوعاً للهيمنة الأمريكية التي ورثت، ما كانوا يخضعون له من قبل من هيمنة استعمارية أوروبية، ثم انظر من قريب أو أفقياً، ترى العرب تحت هيمنة جيرانهم من كل الجهات، هيمنة إيرانية من الشرق، هيمنة تركية من الشمال الغربي، هيمنة إسرائيلية من القلب، هيمنة إثيوبية من الجنوب، هؤلاء الجيران الأربعة، منهم ثلاث قوى ذات تاريخ إمبراطوري عظيم ضارب القدم في تاريخ المنطقة، وهم إيران وتركيا وإثيوبيا، بينما إسرائيل كيان وارد وطارئ وعابر ومفروض على المنطقة بقوة النفوذ الأوروبي، ثم الأمريكي، ولولا هاتان الحمايتان، لما كان لها من وجود، ولما كان لها من بقاء.
العرب دخلوا القرن الحادي والعشرين بغير مشروع وبغير تصور جماعي أو فردي للمستقبل، وقد مضى ربع قرن من القرن الحالي، تأكد فيه تمزق العرب وضعفهم – رغم كل ما يتوفر لهم من مصادر القوة- وفي المقابل يتأكد كل يوم، أن جوارهم الرباعي من إيران إلى تركيا إلى إسرائيل إلى إثيوبيا، يزحف عليهم من كل جانب، ويضغط عليهم بكل سبيل. العرب يبدو طالعهم سيئ وحظهم قليل فبعد أول ثوراتهم- الثورة العربية الكبرى 1916- وقعوا تحت الاحتلالين الفرنسي والبريطاني، وكان طموحهم أن يتحرروا من ربقة السيادة العثمانية، وتكون لهم دولة عربية كبرى فحصل لهم العكس تماماً: احتلال أوروبي أسوأ مليون مرة من السيادة العثمانية، ثم تقسيم وتجزئة وتقرير مصير بيد المستعمرين، ما زالوا يدفعون ثمنه حتى اليوم، وقد زاد على ذلك كله، ميلاد فكرة دولة إسرائيل. ثم بعد آخر ثوراتهم- ثورات الربيع العربي بعد أقل قليلاً من مائة عام على الثورة العربية الكبرى- خابت توقعاتهم أيضاً هذه المرة، فقد أسقطوا عدداً من الديكتاتوريات، دون أن يتمكنوا من بناء ديمقراطية واحدة بل حصل ما هو أسوأ من الديكتاتوريات بدءاً من الفوضى والحروب الأهلية والثورات المضادة وصولاً إلى طبعات جديدة من ديكتاتوريات ناشئة، لكنها أسوأ من تلك التي أسقطتها ثورات الربيع العربي.
خلال القرن العشرين ناضل العرب لتصويب مسارهم في التاريخ في موجتين: الأولى في النصف الأول من القرن سعياً للاستقلال والحكم الدستوري الديمقراطي، وقد حصلوا على الاستقلال، لكن أخفقوا في بناء حكم ديمقراطي. ثم الموجة الثانية من منتصف القرن، حيث دخلوا في مواجهة تاريخية مع الصهيونية والهيمنة الأمريكية، وقد أخفقوا في الهدفين، إذ إسرائيل لا تتوقف عن القوة وإذ الهيمنة الأمريكية تزداد ولا تنقص، بل وإذ إسرائيل صديق وحليف، وإذ الهيمنة الأمريكية مصدر حماية وكفالة وضمان بقاء، لا يمكن الاستغناء عنها.
المشروع الناصري 1952- 1970 كان ذروة الحضور العربي في الإقليم، كانت مصر الناصرية تقود العرب في مواجهة النوعين من مصادر السيطرة على الإقليم، سواء سيطرة الأمريكان من أعلى أو سيطرة الجوار الرباعي من أسفل، كانت مصر الناصرية قد وعت- فكرياً وسياسياً- انكسارات وطموحات ونضالات العرب، ونجحت في التعبير عنها، وكسبت ولاء الجماهير من المحيط إلى الخليج حتى في الأنظمة الملكية المحافظة التي كانت في قرارة نفسها تختلف مع سياسات عبد الناصر، لكنها لم تكن تملك من خيار غير مسايرته في العلن؛ اتقاءً لغضب جماهيرها، فرض عبد الناصر أجواء عربية نضالية، تجاوزت الحدود واخترقت أسوار الأنظمة، مما أعانه على النجاح في صراعاته مع كافة القوى الإقليمية التي وظفها الغرب والأمريكان ضده من باكستان وإيران والعراق الهاشمي والأردن الهاشمي وتركيا الذين خاضوا معاركهم ضد عبد الناصر تحت مسميات غربية مصطنعة، مثل حلف بغداد أو الحلف الإسلامي وهكذا، لكن مشروع عبد الناصر انهزم مرتين: مرة في حياته بهزيمة 5 يونيو 1967 م التي كشفت أن كبير العرب غير قادر على حماية نفسه فكيف يحمي العرب، ثم انهزم بعد مماته حين اتجه السادات بمصر في طريق معاكس تماما، اصطلح السادات مع كل خصوم عبد الناصر في الداخل والخارج، وانقلب على سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وذهب للسلام مع إسرائيل وتفويض أمريكا في تقرير مصير العرب والشرق الأوسط.
مع السادات بدأ خروج مصر من قيادة العرب، ثم بدأ خروج العرب من الصراع، ثم بدأ دخول العرب في السلم الصهيوني الأمريكي. لكن يظل مسار السادات لم يكن نهاية المطاف في تدمير الصف العربي، كان ذلك من نصيب البعث القومي العربي في كل من دمشق وبغداد، فقد تحالفت سوريا البعثية القومية العربية مع إيران الفارسية الشيعية الثورية في حربها ضد العراق 1980- 1988م، هنا عرب ضد عرب، والعجيب كلاهما بعثي قومي عربي يرفع شعار العروبة أولاً، انضربت فكرة العروبة من معاقلها الأيديولوجية المتشددة في دمشق. ثم مع غزو العراق للكويت 1990 انتهت إلى الأبد فكرة، أن العرب أمان للعرب، وأن العرب ضمان للعرب، بل ثبت العكس العرب خطر على العرب ولا مانع، أن يستغيث العربي المظلوم وهو الكويت بأمريكا والعالم لتحريره من غزو الشقيق العربي الذي هو أول وأقرب وأكبر جار. حكم البعث القومي العربي في كل من بغداد ودمشق لم يتسبب فقط في خلخلة مظلة التضامن العربي التي كانت آخر تجلياتها في حرب أكتوبر 1973، وإنما قدم كلاهما نموذجاً في ديكتاتورية أقل ما توصف به- بين كل الديكتاتوريات العربية- أنها سواء في دمشق الأسد الأب، ثم الابن أو في بغداد صدام حسين هي الأكثر استهانة بالإنسان دمه وروحه وأمانه وحياته وحرياته، وقد سقط بعث العراق بالسلاح الأمريكي، ثم سقط البعث السوري بالسلاح التركي في يد المليشيات السورية، ومن قاتل في صفوفها من الأجانب، ذهب صدام لكن لم تتأسس من بعده ديمقراطية في العراق، وكل ما هنالك أن تراث صدام انتقل من يد البعث إلى يد القوى الجديدة ذات العقيدة الشيعية، انتقلت العراق من ديكتاتورية بعثية تنتسب إلى الأقلية السنية إلى ديكتاتورية تنتسب إلى الأغلبية الشيعية، وفي كلا الحالين لم يسلم العراق ولا شعب العراق من الخطرين: خطر الديكتاتورية وخطر الطائفية.
سوريا انتقلت من ديكتاتورية البعث الذي ينتسب إلى الأقلية العلوية إلى ميليشيا مسلحة برعاية تركية، تنتسب إلى الأغلبية السنية، أكثر من نصف قرن من ديكتاتورية الأسدين، لم تترك للشعب السوري من خيار غير الميليشيا وغير الانتداب التركي لحمايتها، في مقابل ما كانت تتمتع به الديكتاتورية البائدة من حماية الروس والإيرانيين وحزب الله اللبناني، ومثلما تراث صدام ما زال حياً يحكم في العراق مع اختلاف وجوه الحكام وانتمائهم الطائفي والمذهبي، فكذلك يرجح أن يبقى تراث الأسد يستعصي على الاقتلاع، حتى لو حسنت نوايا الحكام الجدد الذين يتحدثون لغة سياسية توافقية ناضجة، لكن سوف تكون المحصلة النهائية تعتمد على مدى قدرتهم ونجاحهم في بناء بنية تحتية للديمقراطية، سواء في ثقافة المجتمع أو في مؤسسات الدولة. التخلص من تراث ديكتاتوري تغلغل وتسرب وتسلل إلى أدق تفاصيل الدولة والمجتمع والثقافة في سوريا لأكثر من نصف قرن، يحتاج إلى دراسة ثم خطة، لكن إذا جرت الأمور على طبيعتها دون تخطيط؛ فسوف يعيد الاستبداد إنتاج نفسه، لكن في قوالب جديدة ولغة جديدة ومبررات جديدة.
ضعف العرب وقوة العرب في الشرق الأوسط المعاصر يرتبط كلاهما بضعف وقوة مصر، مصر القوية قوة للعرب، حتى لو تضرر بعض العرب من ذلك، والعكس صحيح فضعف مصر ضعف للعرب في مجموعهم، حتى لو استفاد بعض العرب من ذلك الضعف، لم تكن فكرة القومية العربية لها وجود قوي، عندما نهضت مصر نهضتها العظمى في النصف الأول من القرن التاسع عشر، إلا بعض ما يُنسب إلى القائد إبراهيم نجل محمد علي باشا، أنه كان يرى نفسه- على عكس أبيه- عربي الانتماء ويطمح لإمبراطورية عربية كبرى في وجه العثمانيين. ثم في النهضة الثانية في الثلاثين عاماً بين ثورتي 1919 و1952م، لم يكن هناك أي توجه قومي عربي في البداية، لكن مع انتفاضات الشعب الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني، بدأت تركيبة السياسة المصرية الداخلية، تنفتح على الإخاء العربي، وقد تبلور وجه مصر وقلبها العربي بوضوح في الثلاثينيات وبقوة في الأربعينيات، حتى غدت القاهرة بيت العرب من المحيط إلى الخليج. كانت مصر في الثلاثينيات والأربعينيات ملهمة للعرب سواء في نضالها لأجل الحريات أو لأجل الاستقلال أو لأجل التحديث والتنوير والنهضة بكل معانيها، كانت مصر تسبق إيران بمراحل، وتسبق تركيا رغم أن استقلال مصر كان مقيداً، و لا مجال لأي مقارنة مع إثيوبيا، ولم تكن إسرائيل قد ولدت، ولم تكن أمريكا بسطت هيمنتها على الإقليم، ومن البداهة كانت الفوارق واسعة بين مصر وأشقائها العرب، بما في ذلك مراكز الحضارة في العراق والشام، انتهت حقبة الثلاثين عاماً، ومصر ترفض السلام مع إسرائيل وترفض الانضواء تحت الأحلاف الغربية التي كانت مجرد انتقال من استعمار قديم إلى استعمار جديد.
من هنا بدأ عبد الناصر وقضى قريباً من عقدين من الزمن صامداً في وجه الصهيونية والاستعمار، حتى سقط مشروعه 1967م. في عهد الرئيس السادات ذهب للسلام وضحى في مقابله بالقيادة المصرية للعالم العربي التي كانت حتى ما بعد حرب أكتوبر 1973، دون منافسة ذات خطر من أي بلد عربي، تعجل السادات، وظن أن أمريكا بديل عن العرب، وأن السلام بديل عن قيادة مصر للعرب، ربما لو فكر بطريقة مختلفة، كان احتفظ بقيادة العرب، وأنجز السلام في الوقت ذاته وذلك عبر آلية المؤتمر الدولي للسلام الشامل الذي كان قد انطلق عقب حرب أكتوبر.
الرئيس مبارك فكر بشيء يعيد التوازن بين احتفاظ مصر بالسلام ودورها العربي، فقد استعاد علاقات مصر بالعرب واستعاد الجامعة العربية إلى مقرها في القاهرة بدل المقر الذي انتقلت إليه في تونس، لكن كان الزمن قد تغير، وباتت عواصم مثل الرياض وبغداد ودمشق والجزائر والرباط لها أوزانها المعتبرة في موازين ومعدلات القوة العربية، هنا اكتفى مبارك بعلاقات ندية متكافئة مع كبريات العواصم العربية مع احتفاظ مصر بالمركز الأدبي لوضع الشقيقة الكبرى. ثم من مطلع القرن الحالي استجدت أمور بالغة الأهمية في السياسة العربية: أولها قوة الإعلام والدبلوماسية في عواصم مستجدة تماما على التأثير العربي من موقع قوة، ومن وضع قيادي، مثلما في كل من قطر وأبوظبي بصورة تفوق السعودية ذاتها وبصورة لا يمكن غض البصر عنها أو التقليل من شأنها. وثانيها: تمدد النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة، بصورة استعادت تاريخ الهيمنة الإمبراطورية الفارسية. وثالثها: عودة تركيا بعد مائة عام من سقوط الدولة العثمانية لتلعب من جديد في الشرق الأوسط من شمال إفريقيا إلى الخليج العربي إلى البحر الأحمر وشرق إفريقيا، إلى ما يشبه الانتداب والحماية الاستعمارية في سوريا بعد سقوط البعث 8 ديسمبر 2024. ورابعها: سعي إثيوبيا الحثيث للتحكم في منابع النيل، واعتبار النيل الأزرق ملكية وطنية، تخصها وليس نهراً مشتركاً بين دول المنبع والممر والمصب. وخامسها: مشروع السلام الإبراهيمي الذي يستهدف شرق أوسط، تكون إسرائيل صاحبة السيادة عليه مدعوماً بتخطيط أمريكي، يعلن أنه مع تحديث الشرق الأوسط ويضمر السعي العملي لتفكيك الشرق الأوسط.
………………………………….
في هذا السياق ليس أمام مصر، لمصلحتها، ولمصلحة العرب، إلا أن تعيد النظر بقوة في ركائز سياستها الإقليمية في الربع قرن الجاري من هنا حتى عام 2050.