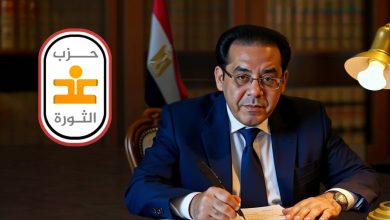وهذا فشل آخر لسياسة إيمانويل ماكرون الخارجية. ورغم أن الرئيس الفرنسي جعل من “تصالح الذكريات” محورا أساسيا
في العلاقات بين فرنسا والجزائر ، إلا أنها أصبحت اليوم أكثر تدهورا من أي وقت مضى. أعقب اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري
بوعلام صنصال في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي أثار ضجة في فرنسا، اتهام مثير للسخرية ضد المديرية العامة للأمن الخارجي، التي كانت، بحسب الصحافة الجزائرية، ستشن عملية سرية لـ “زعزعة استقرار” الجزائر.
يجب علينا بلا شك أن نرى عواقب تغير موقف إيمانويل ماكرون، الذي اعترف، في 30 يوليو/تموز، بـ “السيادة المغربية” على الصحراء الغربية.تعيش ميلاني ماتاريسي في الجزائر منذ خمسة عشر عامًا. بعد أن عملت كصحفية وأطلقت
صحيفة الوطن ويكند ، أصبحت الآن تدير مشروعًا تجاريًا. في كتابها
«كيف خسرت فرنسا الجزائر (مرة أخرى)» (Les Presses de la Cité)، تقدم الكاتبة نظرة رائعة، من الداخل، حول الكيفية التي كان من الممكن أن تتدهور بها العلاقات بين البلدين إلى هذه النقطة.
بالنسبة إلى L’Express، تقوم بتحليل الأزمة الدبلوماسية الحالية، التي وصلت إلى نقطة اللاعودة، وتشرح كيف “حاصر ماكرون نفسه وحيدًا في سباق من أجل الاعتراف والأعمال الرمزية” وفك رموز عمل ومنطق النظام الجزائري الذي أصبح معزولًا دبلوماسيًا بشكل متزايد.
بل وأكثر من ذلك إذا فشلت الصين…
ليكسبريس: اتهم النظام الجزائري والصحافة الحكومية فرنسا بالتخطيط، عبر المديرية العامة للأمن الخارجي، لمؤامرة تهدف إلى تجنيد إرهابيين جزائريين.
وهو ما يعيد إلى الأذهان الاتهامات السابقة وقت قضية بوراوي عام 2023، أو نفس الهجمات الشاملة ضد المخابرات الفرنسية والتي كانت ستتآمر مع الموساد والمغرب لزعزعة استقرار الجزائر…
مستوى جديد- ما حدث في التدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية؟
ميلاني ماتاريسي: إن “قضية المديرية العامة للأمن الخارجي” هذه تضر بالعلاقات الثنائية أكثر مما تبدو، لأنها لا تؤثر فقط على السياسة. فهو يقوض أحد أقدس أسس العلاقة الثنائية: التعاون الأمني بين البلدين.
ومنذ اندلاع الأزمة الكبرى -التي جزء منها هذه الحلقة- في يوليو/تموز الماضي، عقب اعتراف باريس بالطابع المغربي للصحراء الغربية، قطعت الجزائر تقريبا جميع قنوات الاتصال مع باريس، بما في ذلك قنوات المخابرات.
وقد تعامل الأخيرون مع هذه الاستراحة بشكل سيئ للغاية، خاصة أنهم كانوا يعولون في ذلك الوقت على شركائهم الجزائريين لتبادل الأفكار من أجل منع الهجمات المحتملة أثناء استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية.
وهنا يظهر كل التناقض في قصة المؤامرة هذه: فلم تكن باريس والجزائر العاصمة متحدتين دائما، على الرغم من الأزمات السياسية، في الحرب ضد الإرهاب.
لكن قبل كل شيء، نرى بوضوح أن فرنسا ليست لها مصلحة في زعزعة استقرار الجزائر لأنها ستكون أول من يتحمل العواقب.
تتسبب هذه الهجمات المتكررة ضد الخدمات الفرنسية أيضًا في أضرار دائمة داخل المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأمن الخارجي، حيث يثير حتى أكثر المدافعين حماسة عن الجزائر مشكلة ثقة.
كيف تفسرون اعتقال بوعلام صنصال عن عمر يناهز 80 عاما، وهو أمر صادم للغاية في فرنسا؟إن اعتقال بوعلام صنصال صدم بشدة هذا الجانب من البحر الأبيض المتوسط منذ أن نظرنا إليه، وهذا أمر طبيعي، من خلال منظور فرنسي: إنه اعتداء على حرية التعبير، لقد “تغمرنا” (اختيار الكلمة أيضا المنير) كاتب، رجل يبلغ من العمر 80 عاما، مفكر حر، الخ.
أما بالنسبة للسلطات الجزائرية فإن المنظور مختلف قليلا. أولويتهم هي إدارة نوعين من الضغوط التي يمكن، إذا لم يتم احتواؤها، أن تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
الأول داخلي
الجزائر بلد كبير جدًا (أكبر بأربع مرات من فرنسا)، وسكانه متباينون بين شمال وجنوب البلاد، وهم صغار جدًا (70% من السكان أقل من 40 سنة)، ولها احتياجات مهمة في مجال السكن، العمالة والطاقة والتي تشهد ديناميكيات داخلية قوية جدًا. أما بالنسبة لمن هم في السلطة، فالتحدي هائل.
والثاني خارجي
منذ سقوط القذافي، أصبحت ليبيا مصدر قلق دائم. وفي أوائل أغسطس، شن صدام حفتر، نجل حفتر، هجوما على المناطق الغربية والجنوبية بالقرب من الحدود مع الجزائر والنيجر، مما تسبب في تجدد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
كما أدى الانقلابان في مالي والنيجر إلى تعطيل العلاقات بشكل كامل مع الجزائر وباماكو ونيامي التي رفضت تحكيم جارتها الجزائر الكبيرة التي تخشى بحق تطوير منطقة الساحل على حدودها.وأخيرا، وقبل كل شيء، يستمر الوضع في التدهور بين الجزائر والرباط.
بالنسبة للجزائر، لا شك أن التطبيع بين المغرب وإسرائيل، الذي كان أصل قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2021، يهدف إلى زعزعة استقرارها.
وسواء كانت هذه القناعة مبررة أم لا، فإن كل ما في الأخبار الدولية يشير إلى أن فقدان النفوذ الإقليمي سيترافق مع عزلة دبلوماسية أكبر للجزائر، خاصة إذا قامت الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب الثاني بتصنيف جبهة البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية، إذا فهو يدفع نحو موجة ثانية من التطبيع مع إسرائيل (اتفاقيات إبراهيم الثاني بدعم من السعودية بقيادة محمد بن سلمان)، وخاصة إذا، كما نفهم أقوى وأقوى، والصين، التي تعتبرها الجزائر حليفتها، تعترف بدورها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
“عبد المجيد تبون هو بالفعل صانع القرار الرئيسي”وفي هذه الأجواء، هناك مواضيع تثير غضب الجزائر، خاصة تلك المتعلقة بسلامة أراضيها أو عدم وضوح حدودها.
لذلك عندما يعلن أحد مواطنيها، الذي أعرب بالفعل عن تعاطفه مع إسرائيل أو الذي يناقش مع أعضاء حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل (MAK، المصنفة إرهابيًا من قبل الجزائر)، على وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة، منذ الخارج، أن في زمن الاستعمار الفرنسي، كان غرب الجزائر مغربياً، مما جعل السلطة الجزائرية تشعر بالهجوم.
ومن منظور فرنسا، يبدو النظام الجزائري غامضاً على نحو متزايد. من يملك القوة اليوم؟ الرئيس تبون ؟ الجنرال القوي سعيد شنقريحة؟ البيروقراطية؟من فرنسا، تبدو الجزائر بأكملها مبهمة. إنه حتى “الثقب الأسود”. ولسبب وجيه، فإن المعلومات الأكثر سهولة هي تلك الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي والمعارضين الخارجيين بدوافع مشكوك فيها في كثير من الأحيان. ومما يزيد الطين بلة أن كل هذه المعلومات تتم قراءتها من خلال الكليشيهات التي يستغلها على نطاق واسع جزء من الطبقة السياسية الفرنسية، مثل اليسار الأبوي واليمين المتطرف “الحنين”، والتي تصف الجزائر بأنها نوع من أفغانستان في العالم. وصناعة مجتمع جامد ومتجانس غارق في الإسلاموية ويقوده جنود ذو شوارب يلوحون بدمية رئيس. الكليشيهات المطلقة.
ويبقى التحيز الآخر هو صعوبة وصول الباحثين والصحفيين وغيرهم إلى الأراضي الجزائرية، بسبب عدم وجود تأشيرات: وهذا يعزز صورة الأرض المجهولة التي تفرض، بما يتجاوز تعقيد الوضع الجزائري، فكرة “التعتيم”. ومع ذلك، فإن شهادات الجزائريين، على اتصال مباشر مع السلطات المدنية والعسكرية، كلها تشير إلى نفس الثابت:
عبد المجيد تبون هو بالفعل صانع القرار الأساسي، وهو ما لا يمنعه من التبادل مع العسكريين دون أن يكون هناك بالضرورة أي سبب.
علاقة التبعية
إذا كان عمل النظام الجزائري – البلازما التي تدور فيها الرئاسة وصناع القرار العسكري وأجهزة المخابرات والإدارة المركزية القوية، في حركة مستمرة وفوضوية إلى حد ما لتوليد القرارات – أصبح أكثر غموضا منذ عام 2019، فذلك لأنه لم يفعل ذلك.
أنهى استقرار الجهاز بعد الاضطرابات الكبيرة المتمثلة في الحراك الذي هز النظام بشكل عميق من خلال إعادة توزيع الأوراق بعد عشرين عاما من حكم بوتفليقة.
وقد فرض الأخير هيمنة وهمية لـ “واجهة” مدنية تواجه الجيش والدولة العميقة (لا سيما أجهزة المخابرات والإدارة).
منذ عام 2019، تغيرت البيانات بسرعة كبيرة, سوف يتطلب الأمر جهداً تحليلياً، بعيداً عن الكليشيهات المذكورة أعلاه، لفهم التعقيد العقلاني لميزان القوى في الجزائر.
للقراءة، مع ذلك، كان لعبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون علاقات شخصية أكثر بكثير من، على سبيل المثال، ماكرون مع ملك المغرب محمد السادس. لماذا ؟
لقد أراد إيمانويل ماكرون حقاً المراهنة على عبد المجيد تبون. مما لا شك فيه قليلا من الانتهازية.
يدرك رئيس الدولة الفرنسية تمام الإدراك “الصدمة الجزائرية” في فرنسا ويحلم بمصالحة كبيرة بين الشعب الفرنسي (لقد جعل الذاكرة المكبوتة لحرب الجزائر واحدة من أرض خصبة للانفصالية) ولكن أيضًا بين باريس والجزائر العاصمة. .
ولا شك أيضًا أن الرئيس الجزائري هو المحاور المثالي لفرنسا:
أناوهو ينتمي إلى جيل لم يخوض حرب التحرير بل تشكل من التراكم التاريخي لهذه الفترة. وهو أول رئيس جزائري منذ 1962 ليس مجاهدا
( مقاتل في جيش التحرير الوطني، الجناح المسلح لجبهة التحرير الوطني 1954-1962)، في حين أن أبه عالم وطني تعرض للاضطهاد من قبل الإدارة الاستعمارية في ذلك الوقت.
تبون هو راوي لا ينضب للحكايات والقصص عن فرنسا والجزائر، ولديه حس الحضور. وكما أوضحت في الكتاب، كان اختيار الممثلين مثاليًا على الورق.
يشترك الرجلان في الصراحة، فهم يحتقرون عناصر اللغة، ويتحملون مسؤولية زلاتهم وصراحتهم. أخيرًا، يعد عبد المجيد تبون شريكًا أقل إشكالية من
محمد السادس : فالحكومة الجزائرية لم تتجسس أبدًا على إيمانويل ماكرون باستخدام برامج التجسس الإسرائيلية، كما أن عائلته لم تقتحم باريس وتعيث فسادًا في الفنادق.
جعل إيمانويل ماكرون من الذاكرة محورا أساسيا في محاولته المصالحة مع الجزائر، معترفا بتعرض الزعيم الوطني علي بومنجل للتعذيب والاغتيال على يد الجيش الفرنسي، أو متفكرا إلى جانب أخطاء ضحايا مذبحة 17 أكتوبر 1961. هل ذهب إلى هذا الطريق؟
لقد عمل إيمانويل ماكرون جاهدا لجعل الذاكرة موضوعا رئيسيا للمصالحة.
في فرنسا، لم تشكل مسألة المصالحة بين المجتمعات التذكارية (الأقدام السوداء، والمجندون، والحركيون على وجه الخصوص) خطرًا سياسيًا كبيرًا بالنسبة له.
ومن ناحية أخرى، فإن استخدام التاريخ لأغراض دبلوماسية، خاصة مع الجزائر، يمثل مخاطرة هائلة.
ومن خلال ربط العلاقات الثنائية بقضية لن يتم حلها أبدا، فقد حاصر الرئيس ماكرون نفسه في سباق من أجل الاعتراف، وكانت الأفعال الرمزية تؤدي إلى إطالة أمد الألم، وليس حله.
لأنه جر السلطات الجزائرية رغما عنها إلى عملية كانت مرهقة للغاية بالنسبة لها.
من الصعب اليوم في الجزائر القيام بالعمل على المصالحة عندما يواجه الأكاديميون صعوبة في الوصول إلى الأرشيف الوطني أو يواجهون عقبات بيروقراطية.
ونتيجة لذلك، أُغلق الفخ على إيمانويل ماكرون.
إن الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال العربي بن مهيدي، أحد رموز الثورة الجزائرية، كان بمثابة مبادرة قوية للغاية، خاصة بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع حرب الاستقلال.
إلا أن هذه اللفتة جاءت بعد أيام قليلة من خطاب الرئيس أمام البرلمان المغربي في الرباط، حيث أكد مجددا أن “حاضر ومستقبل” الصحراء الغربية “جزء من إطار السيادة المغربية”، وأكد أن فرنسا ستستثمر في الصحراء الغربية. إذا لم يكن الأمر مقصوداً، فقد اعتبرت حادثة “العربي بن مهيدي” بمثابة تعويض مهين في الجزائر العاصمة.
من وجهة نظر استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية بحتة، أليس لفرنسا مصلحة في “اللعب” مع المغرب، كما فعلت الولايات المتحدة أو إسبانيا أو ألمانيا، بدلا من الجزائر، التي زادت تعاونها مع روسيا؟ الأول وضع نفسه بوضوح في المعسكر الغربي، ويقدم إطارًا أكثر طمأنينة وجاذبية للشركات ويحافظ على قدر أقل بكثير من الاستياء التذكاري فيما يتعلق بالتاريخ الاستعماري…
التجارة بين فرنسا والمغرب تتقدم كل عام، استعادت فرنسا المرتبة الثانية كمورد في عام 2022 متقدمة على الصين، وتبقى المورد الرئيسي للعملة الأجنبية للمملكة، والمستثمر الأجنبي الأول لها وأول بلد منشأ للتحويلات من الجالية المغربية و عائدات السياحة. ومن الواضح أن الحجة الاقتصادية تصمد.
“في غضون سنوات قليلة، في الجزائر، لن يتحدث الفرنسية إلا جزء من النخبة المثقفة”لكن فرنسا لا يمكنها أن تنسى أن لديها ما يزيد قليلاً عن مليوني جزائري وفرنسي جزائري على أراضيها.
فهل تتمكن فرنسا أيضاً من الاستغناء عن العلاقات الطيبة مع أكبر دولة في منطقة المغرب العربي، والتي، على الرغم من الحساسية الدبلوماسية، تدفعها في الواقع إلى لعب دور إقليمي مهم في الحرب ضد الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية؟
وإذا كان النظام الجزائري قد وجد في فرنسا هدفا سهلا لصرف الانتباه عن إخفاقاته، فإن اليمين الفرنسي واليمين المتطرف وجد أيضا في الجزائر، حسب قولك، “هدفا مناسبا لتبرير السياسات المناهضة للهجرة”.
هل نركز كثيرا على هذه الهجرة الجزائرية؟
أكثر مما ينبغي, يتم التلويح بالمهاجر الجزائري باعتباره الشخص المسؤول عن كل أمراض فرنسا.
صحيح أنه في الوقت الحالي يسعى عدد معين من الجزائريين، وخاصة الخريجين، إلى الوصول إلى فرنسا، لأنهم لا يستطيعون العثور على عمل في الجزائر.
إن فترات الهجرة هذه، كما نرى عبر التاريخ، دورية.
إذا سألت جزائرياً في الشارع عما إذا كانوا يفضلون الذهاب إلى أوروبا أو البقاء في وطنهم، فسوف يجيبون دائماً أنهم يفضلون العيش في بلدهم.
المشكلة هي أن الجزائر اليوم تسبب إرهاقا كبيرا للطبقة السياسية الفرنسية، من اليمين ومن اليسار. وبما أنه أصبح من الصعب الدفاع عنه، أصبح لدى اليمين المتطرف منفذ لقول أي شيء وكل شيء. مثل
سارة كنافو التي يمكنها أن تعلن بهدوء أن فرنسا تقدم 800 مليون يورو كمساعدة للجزائر كل عام.
في الواقع، تم توزيع هذا المبلغ على خمس سنوات، وهو ليس أموالا للمساعدات التنموية بل منح دراسية مختلفة مقدمة للطلاب الجزائريين.
مثال آخر: اليمين واليمين المتطرف جعلوا من اتفاق 1968 هاجسا ويطالبون بمراجعته بحجة أنه سيكون في صالح الجزائريين أكثر من اللازم.
من الناحية العملية، في العديد من الجوانب (حصول الطلاب الجزائريين على فرص العمل)، يكون النص غير مواتٍ لهم أكثر من القانون العام.
أنت تشير إلى أن رفض فرنسا في الجزائر، وبشكل عام في منطقة الساحل، يغذيه الشعور بالتراجع الفرنسي وفقدان النفوذ على الساحة الدولية. حقًا ؟
أساسًا,هذا التراجع، الذي يمكن ملاحظته بوضوح عندما تكون في الخارج، في لبنان كما في السنغال، وليس فقط في الجزائر، بدأ قبل بضع سنوات.
وفي القارة الأفريقية، ظهر جيل جديد ونخب جديدة، تنتقد بشكل خاص السياسة الخارجية الفرنسية، وتتهم باريس بدعم الأنظمة الاستبدادية باسم مصالحها الاقتصادية، وتدين العلاقة غير المتوازنة، وتتوق إلى الانفصال عن التراث الاستعماري، وتطالب المزيد من الاستقلال السياسي والاقتصادي.
ويبدو أن فرنسا الرسمية لم تقيس العواقب المترتبة على هذا التساؤل. وعلى أية حال، فقد ظلت عاجزة في مواجهة الديناميكيات الجديدة والمطالب السيادية الجديدة.
ولم تفهم أن تدخلاتها العسكرية، وخاصة في ليبيا عام 2011، تسببت في قطيعة عميقة مع الحكام والسكان.
ولم تسمع الأصوات التي تهمس لها بأن عمليات برخان/سرفال وحدها – دون تنمية اقتصادية، ودون مشاركة باماكو، ودون “سياسات متكاملة” كما طلبت الجزائر في ذلك الوقت… – لن تكون فعالة في منطقة الساحل لاحتواء المسلحين.
الجماعات الإسلامية
وفي الوقت نفسه، حتى مع تراجع جاذبيتها الاقتصادية، فإنها لم تطور قوتها الصارمة ولا قوتها الناعمة في مواجهة وصول قوى متنافسة هائلة إلى أراضي نفوذها، مثل الصين وروسيا وتركيا.
أو حتى دول الخليج التي نعطي انطباعًا أحيانًا بأنها تابعة لها.
اللغة الفرنسية تشهد تراجعاً حاداً في الجزائر، والنظام يدفع باللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، ووفقاً لك، فإن المدارس الفرنسية يتم الالتحاق بها بدافع البراغماتية أكثر من حبها للغة. هل لغتنا مدانة في الجزائر؟
خلال سنوات قليلة، لن يتحدث الفرنسية إلا جزء من النخبة المثقفة، وفي أفخم أحياء العاصمة.
لقد اختارت النخبة السياسية اللغة العربية، أما النخبة الاقتصادية الموجهة نحو الشرق الأوسط فقد اختارت اللغة الإنجليزية، بسبب العولمة وسهولة الحصول على تأشيرات الدخول إلى الخليج.
وفي القطاع الخاص، يتحدث الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا اللغة الجديدة، وهي مزيج من اللغة الدارجة (اللهجة الجزائرية) والإنجليزية.
ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى مطاردة الفرنسيين بقيادة الجزائر. يتم تضمين اللغة الفرنسية من حيث المبدأ في البرنامج في السنة الثالثة من المدرسة الابتدائية (أي ما يعادل CE2).
لكن في مواجهة ندرة المعلمين المدربين لمثل هذه المهمة، اختفت تدريجيا من الجداول الزمنية. وفي الوقت نفسه، منذ عام 2022، أصبحت اللغة الإنجليزية إلزامية في نفس العمر.
وفي الجامعة، يقاوم بعض المعلمين في بعض المواد، وخاصة العلوم، التدريس باللغة الإنجليزية، ولكن تحت ضغط الأجيال الجديدة التي سيتم تدريبها باللغة الإنجليزية فقط، سيحدث التحول حتماً.
ولكن من الممكن أن نعزو تراجع اللغة الفرنسية أيضاً إلى تأخر فرنسا في النظر إلى الثقافة واللغة كأدوات للقوة الناعمة في خريطة الطريق الدبلوماسية.
وبينما كانت الدبلوماسية الفرنسية تتباهى برؤية هذا العدد الكبير من الجزائريين يلتحقون بدورات اللغة الفرنسية، منجذبين إلى ما كان يعتبره “حب اللغة الفرنسية”، فإنها لم تسمع هؤلاء الشباب أنفسهم يضحكون على اللغة الفرنسية، لغة “فيكتور هوغو” (افهم). : عفا عليها الزمن) و”روايات الحب”.
خلال كل هذه السنوات، كانت معاهدها الفرنسية الخمسة (!) في الجزائر تتباهى ببرنامج عروض الرقص والمؤتمرات والمسرحيات التي كانت فوق الأرض تمامًا.
ما الذي تعتقد أنه ينبغي على السلطات الفرنسية فعله لمنع العلاقات بين البلدين من التدهور التام؟
يشاع في أوساط مطلعة بالجزائر العاصمة أن القطيعة كاملة بين الرئيسين, كان عبد المجيد تبون سيعتبر التحالف بين باريس والرباط خيانة, سبب للحرب.
إن كون العلاقات الثنائية مرهونة اليوم من قبل إيمانويل ماكرون بينما كان يسعى منذ البداية، على الرغم من الأخطاء الفادحة، لصالح الجزائر، هو تحول محزن.
لكن هذا يقول شيئاً أساسياً: لا ينبغي لمحور باريس-الجزائر أن يكون رهينة التفاهم الجيد بين رجلين.
ويجب أن تبنى على شراكات أمنية واقتصادية وثقافية متينة، تدعمها إدارات مهيأة لمقاومة المخاطر السياسية.
ويتعين علينا أن نبتعد عن المنطق الشخصي لإعادة بناء الآليات التي تم وضعها في عهد فرانسوا هولاند، ووضع إطار للمشاورات السياسية، على غرار ما حدث بين فرنسا وألمانيا.
إن هذه اللقاءات المنتظمة هي التي تجعل من الممكن قول الأشياء لبعضنا البعض، ونزع فتيل التوترات قبل أن تصبح خارجة عن السيطرة، وفي أسوأ الأحوال، إيجاد حلول للأزمات.
وقبل ذلك، فإن باريس -لأنها باريس التي باختيارها الحل المغربي، مع علمها التام بعواقبه، هي المسؤولة عن الأزمة الحالية- يجب أن تكون استباقية من خلال اقتراح خطة للخروج من الأزمة.
سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن من خلال تعبئة الأشخاص المناسبين على المستوى المؤسسي (إرسال مبعوث محايد، وهي خطة أثبتت فعاليتها بالفعل)، بدعم من الشبكات غير الرسمية للعلاقات الثنائية، في غضون بضعة أشهر، سيكون من الممكن تجديد الحوار.