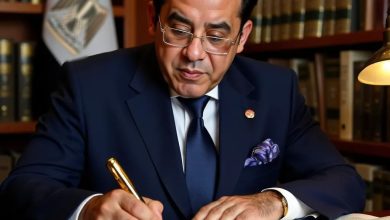كشف الزلزال الذي ضرب سورية، وما تزال توابعه تهز جنبات المنطقة بأسرها، عن مشهديْن يجسّدان واحدة من أهم المعضلات التي تواجه العقل العربي، وتحدّ من قدرة الشعوب العربية على بناء مؤسّسات تمكنها من الانطلاق، والمساهمة من جديد في صنع الحضارة العالمية. الأول: جسّده سقوط النظام الحاكم في سورية، وفرار رئيسه بشّار الأسد إلى موسكو خفية وفي جنح الظلام. والثاني: جسّده ذلك الانقضاض الوحشي لآلة الحرب الإسرائيلية على ما تبقى من الجيش السوري المنهار إلى أن جرى تدميره كليّاً، ومكّن الكيان من احتلال مساحات جديدة أضيفت إلى الأراضي السورية المحتلة منذ حرب 1967. وبينما يفصح المشهد الأول بوضوح عن حجم الخراب الذي يمكن أن يصيب أياً من الدول التي تغيب عنها الديمقراطية، ما قد يساعد على تعزيز القناعة باستحالة التعايش مع الاستبداد وحتمية هزيمته شرطاً أساسياً من شروط تقدّم الشعوب وازدهارها. يفصح المشهد الثاني، بالقدر نفسه من الوضوح، عن تمتّع الكيان الصهيوني بشهية توسّعية تبدو جاهزة على مدار الساعة لالتهام كل شبر من الأراضي، يعجز العالم العربي عن الدفاع عنه، ما قد يساعد على تعزيز القناعة باستحالة التعايش مع المشروع الصهيوني وحتمية هزيمته شرطاً أساسياً من شروط التقدّم والازدهار.
ورغم ما ينطوي عليه هذا الطرح من مسلّمات تبدو بديهية، إلا أن العقل العربي ما يزال عاجزاً عن حسم قضية ترتيب الأولويات بين الأهداف المتعلقة ببناء الديمقراطية والأهداف المتعلقة بمواجهة المشروع الصهيوني، وكلاهما لازم وضروري وحتمي، للانعتاق من أسر التخلف والتبعية، فبينما يرى بعضهم أن بناء نظم ديمقراطية يعدّ شرطاً ضرورياً لتمكين العالم العربي من مواجهة المشروع الصهيوني بطريقة أكثر فاعلية. ويرفض، بالتالي، التماس الأعذار لتبرير الاستبداد، يبدو آخرون مستعدّين للتسامح مع النظم الاستبدادية التي تتبنّى خطاباً مناهضاً للمشروع الصهيوني، وهو ما يفسّر انقسام النخب العربية تجاه نظام بشّار الذي تعامل معه باعتباره ركناً أساسياً من أركان محور المقاومة، على الأقل بسبب دوره حلقة وصل لتأمين وصول السلاح إلى المقاتلين في حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة. غير أن ما جرى في سورية ينبغي أن يشكل حافزاً لدفع الجميع إلى إعادة التفكير في هذه الإشكالية، خصوصاً وأن استبداد النظام السوري وفساده أدّيا، في النهاية، إلى إلحاق أفدح الأضرار بالمقاومة أيضاً.
يتصرف نتنياهو وكأن جيشه هو من أطاح نظام الأسد، وليس قوى المعارضة السورية
كان انهيار الجيش السوري بهذه السرعة أمراً صادماً، غير أن هروب قائده الأعلى إلى الخارج، بهذه الطريقة المهينة، كان كاشفا للمعدن غير النفيس لهذه القيادة، ويدفع إلى رفض كل ما يُساق من حجج أو أعذار لتبرير ما جرى. ربما تفسّر قسوة العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سورية، من ناحية، وشدّة الضربات العسكرية التي تلقاها حلفاء النظام، من ناحية أخرى، بعض هذا الذي جرى. غير أن القائد الذي يترك الأوضاع في بلاده تتدهور إلى درجةٍ تؤدّي إلى اضطرار ما يقرب من نصف شعبه إلى الهجرة أو اللجوء، وإلى احتلال قوى أجنبية عديدة أجزاء ومناطق واسعة من بلاده، وإلى تدمير البنية الأساسية لدولةٍ كانت قد اقتربت كثيرا من تحقيق اكتفاء ذاتي بالنسبة لمعظم السلع الأساسية، خاصة الزراعية، ويمارس، في الوقت نفسه، سياسات قمعية ضد مواطنيه الذين ألقى بعشرات الألوف منهم في السجون، وعرّض كثيرين منهم للتعذيبين، الجسدي والنفسي، لا يمكن التماس أي نوع من الأعذار له، بل ولا يمكن أن يكون مقبولاً وفقا لأي معيار وطني أو قومي أو إنساني. ذلك أن سياساته التي لم يكن لها سوى هدف وحيد، التشبث بالسلطة ختى النهاية، لم تلحق الأذى بشعبه أو بالدولة السورية وحدهما، وإنما بشعوب العالم العربي ودوله كلها، ولم تؤدّ إلى تغييب المسألة الديمقراطية وحدها، وإنما ألحقت ضرراً فادحاً بقضية المقاومة أيضا.
شعور الشعب السوري بسعادة غامرة لتمكّنه من التخلص من نظام فاسد وجبان طبيعي ومستحقّ، لأنه شعبٌ حيٌّ يستحقّ بالتأكيد نظاما أفضل. ولذا نتمنى، بإخلاص، أن ينجح في تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي وملهم لغيره من الشعوب العربية التي ما تزال ترزخ جميعها تحت نيْر الاستبداد، غير أن هذا الشعور المستحقّ بالسعادة للتخلص من نظام فقد كل مبرّر لاستمراره لا ينبغي أن يخفي شعوراً عميقاً بالقلق مما هو آت، فالقوى التي أطاحت نظام بشار الأسد لا تملك رؤية واضحة للنظام الذي ينبغي أن يحلّ محله، والجذور السياسية والأيديولوجية لمعظم القيادات التي برزت عقب رحيله لا توحي بأن لديها إيمانا عميقا بالديمقراطية أو على دراية واعية بمقوماتها الأساسية. صحيح أن التصريحات الحالية لزعيم سورية في مشهدها الراهن، أحمد الشرع، الملقب سابقاً أبو محمّد الجولاني، تبدو مطمئنةً إلى حد كبير، لأنها تتحدّث عن نظام تشارك في صنعه وإدارته جميع القوى السياسية والتيارات الأيديولوجية، لأن العبرة بالأفعال وليس بالأقوال، خصوصاً وأن التحدّيات الداخلية والخارجية التي ستواجه سورية في المرحلة المقبلة هائلة وخطيرة. ويكفي أن نتذكر هنا ما آلت إليه “ثورات الربيع العربي” التي نجحت في إطاحة رؤوس نظم استبدادية كثيرة في العالم العربي، وفشلت في بناء نظم بديلة أكثر ديمقراطية، لنتبيّن، بوضوح، أن لهذا الشعور العميق بالقلق ما يبرّره.
الجذور السياسية والأيديولوجية لمعظم القيادات التي برزت عقب رحيل الأسد لا توحي بأن لديها إيماناً عميقاً بالديمقراطية
على صعيد آخر، يتصرف رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، وكأن جيشه هو من أطاح نظام بشّار الأسد، وليس قوى المعارضة السورية، فهو يعتقد أنه لولا الضربات القاسية التي جرى توجيهها إلى قوات حزب الله وتجهيزاته في لبنان، وللقوات الإيرانية على الساحة السورية، لما استطاعت هيئة تحرير الشام أو قوات المعارضة السورية الأخرى إسقاط نظام بشار، ولهرع لنجدته حلفاؤه، ولربما تمكّنوا من إنقاذه. لذا قرّر نتنياهو على الفور أن يتقاضى الثمن باهظاً، بالقيام بعملية شاملة وسريعة لتدمير الجيش السوري، الذي هو في النهاية ملك للشعب وللدولة السورية، فقد نفّذ جيش الكيان مئات الطلعات الجوية للإغارة على جميع المواقع التي فيها أسلحة استراتيجية أو ثقيلة يملكها الجيش السوري، وتم تدميرها من دون أن تصدُر عن أيٍّ من رموز النظام الجديد إشارة اعتراض واحدة. لذا يمكن القول إن نتنياهو يشعر بأنه أول المستفيدين من سقوط نظام بشّار، وأن هذا السقوط مكّنه ليس من إلحاق هزيمة كاملة بكل أطراف محور المقاومة فحسب، وإنما أيضاً من فتح الطريق أيضاً أمام إمكانية توجيه ضربة قاصمة لإيران، قلب هذا المحور ومركزه الرئيسي، بل لا مبالغة في القول إن نتنياهو يشعر بأنه حقق نصراً استراتيجياً يتيح له القدرة على أن يشرع على الفور في إعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يتفق ومصالح المشروع الصهيوني الذي يستهدف إقامة دولة يهودية كبرى، تعيد بناء “الهيكل الثالث”. وبالتالي، ما حققه في الأسابيع الماضية لا يقل أهمية عن النصر الذي حققته إسرائيل في حرب 1967. ولذلك، الأرجح أن لا يسمح نتنياهو أبدا بقيام دولة سورية قوية، حتى ولو كان نظامها نموذجيا في الديمقراطية، ويرى أن الفرصة باتت سانحة أمامه للعمل على تقسيم سورية إلى كانتونات ترسم حدودها الجغرافية وفق معايير طائفية أو، على أحسن الفروض، أن يدفع في اتجاه العمل على إقامة نظام سياسي سوري على غرار النظام العراقي أو اللبناني.
كشف ما جرى في المنطقة في الأشهر الأربعة عشر الماضية الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني، أنه يرتكز على القوة وحدها، وليس على التسويات الدبلوماسية أو الحلول الوسط، ولن يتخلى مطلقاً عن حلمه في إقامة الدولة اليهودية الكبرى بالقوة المسلحة إذا تطلب الأمر. لذا لا يعنيه أن تكون النظم السياسية القائمة في الدول العربية المحيطة، أو حتى في الدول الشرق أوسطية البعيدة، ديمقراطية أو استبدادية، يحكمها سنة أم شيعة أم دروز أم أكراد أم أفارقة، بقدر ما يعنيه أن تتصرّف هذه الدول على أساس أنه لم يعد أمامها من خيار سوى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية كاملة مع دولة يهودية كبرى، ينبغي الاعتراف بأنها باتت الدولة المهيمنة في المنطقة، والمسؤولة عن تحديد جدول أعمالها ورسم سياساتها. ولأنه يستحيل على الشعوب العربية أن تقبل هذا المنطق المذل، لم يعد أمامها من خيار آخر سوى إقامة نظم سياسية قادرة على مقاومة مشروع الهيمنة الصهيونية على المنطقة. بعبارة أخرى، يمكن القول إن هذه النظم ستستمد شرعيتها في المرحلة المقبلة من قدرتها على مواجهة هذا المشروع فعلاً، وليس التظاهر بمواجهته، ما يتطلب أن تكون قادرة على توحيد كل القوى التي ترى أن المشروع الصهيوني مصدر الخطر الرئيسي على الأمة، بصرف النظر عن الانتماءات الأيديولوجية أو السياسية أو الطائفية لهذه القوى.