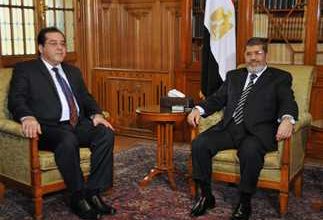في عالم يزداد قسوة، وتعلو فيه أصوات الكراهية والتعصب والسلطة العمياء، يبدو موت البابا فرنسيس أشبه بوداعٍ لرجل طيب في زمن لا يرحم الطيبين.
المؤسسة الكنسية الكاثوليكية، التي يقف على رأسها الفاتيكان، تُعد من أقدم مؤسسات السلطة في العالم، وأكثرها انغلاقًا ومحافظة. دولة بحجم حي صغير، لكنها تملك من الرمزية والسلطة والذهب ما يجعلها أشبه بإمبراطورية دينية متوارثة.
من يزور متاحف الفاتيكان يرى بعينه كيف تأسست هذه المؤسسة على تاريخ طويل من النهب باسم الإيمان، واحتكار “القداسة” و”الحقيقة”، مع طبقة كهنوتية تشبه الأرستقراطيات الحاكمة أكثر مما تشبه الرهبان الفقراء.
في هذا السياق، بدا اختيار البابا فرنسيس، في 2013، كأنه محاولة لتقديم وجه جديد، مختلف نسبيًا، لزمنٍ كان يموج بحركات احتجاج وتمرد من كل الجهات. رجل من أمريكا اللاتينية، بأصول متواضعة، نبرة خطاب إنسانية، وملامح قريبة من الناس.
كان العالم وقتها لا يزال تحت تأثير موجات التغيير الكبرى: من الربيع العربي، إلى احتلال وول ستريت، وحركات الطلاب في تشيلي وإسبانيا والبرازيل. بدا أن الكنيسة اختارت، ولو من باب العلاقات العامة، بابا يواكب اللحظة.
لكن المفاجأة أن الرجل لم يكن مجرد واجهة أو ديكور ناعم، فرنسيس قرر من اللحظة الأولى أن يخوض المعركة من الداخل. تخلى عن القصر البابوي، وركب سيارة بسيطة، وارتدى ثيابًا متواضعة، وبدأ يفتح ملفات لم يجرؤ من قبله على الاقتراب منها: الفساد المالي في الفاتيكان، التواطؤ مع الأنظمة، فضائح الاعتداءات الجنسية على الأطفال داخل الكنيسة، وصمت المؤسسة الكهنوتية عن تلك الجرائم لعقود.
فرنسيس أيضًا لم يتردد في إعلان انحيازه الواضح للفقراء والمهمشين والمهاجرين. تحدّث عن فلسطين بوضوح، وعن حقوق اللاجئين، وعن المناخ، وعن عدالة التوزيع الاقتصادي. اقترب من المسلمين، ومن أصحاب الديانات الأخرى، ورفض استدعاء لغة “التفوق الكاثوليقي” التي كانت سائدة لعقود.
لم يكن ثوريًا بالمعنى الكامل، لكنه حاول. حاول أن يُصلح من الداخل، أن يُعيد للكنيسة بعضًا من روحها الأولى، قبل أن تبتلعها السلطة والذهب والتراتبية. وكانت محاولته، في ظل تركيبة الفاتيكان الصلبة والمعقدة، أقرب إلى معجزة صغيرة.
لكن الزمن تغيّر. الثورات هُزمت، وخرج اليمين المتطرف من جحوره، والعالم عاد إلى صراعاته القديمة، أكثر وحشية، وأكثر فجاجة. أصبح صوت البابا فرنسيس هامشيًا في عالم يصفق للديكتاتور، ويصمت عن القتل، ويخاف من “الآخر”. في هذا الزمن، بدا فرنسيس وكأنه آخر الحالمين.
رحيله ليس مجرد فقدان رأس الكنيسة الكاثوليكية، بل هو لحظة رمزية لنهاية زمن. الرجل الذي حاول أن يُقرّب الدين من الإنسان، لا أن يُخضع الإنسان للدين؛ الرجل الذي جعل كثيرين من غير الكاثوليك يحترمونه ويستمعون إليه، ويرون فيه وجهًا آخر للإيمان… رحل.
فرانسيس كان رجل دين يشبهنا. يشبه فقرنا، وتعبنا، وأسئلتنا. لم يزعم امتلاك الحقيقة، ولم يختبئ خلف لقب “قُداسة البابا”. رحيله موجِع، لأنه يذكّرنا بأن الطيبين نادرون، وأن من يحاول الإصلاح وسط مؤسساتٍ مترهّلة ومحاصرة بالفساد، غالبًا ما يُهزم.
لكنه، رغم كل شيء، حاول وسيبقى في الذاكرة، لا كحاكمٍ على عرش ديني، بل كإنسان حمل التاج دون أن يخلع قلبه.