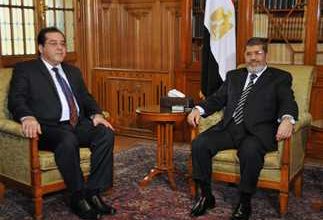الدكتور أيمن نور يكتب: 19 أبريل .. عندما كتب الشعب دستوره

في التاسع عشر من أبريل عام 1923، لم تكن القاهرة مجرد مدينة تُقرع فيها الطبول، بل كانت وطنًا يحتفي بنفسه، يحتفل بولادة دستور خرج من رحم الثورة، لا من قصور السلاطين. كانت مصر كلها تقرأ سطورًا كُتبت بمداد الحلم الوطني.
من دواعي الفخر أن شعبنا، منذ 106 أعوام، رفع شعار “الاستقلال والدستور” في ثورة 1919. كان يعلم أن التحرر من الاحتلال لا يكتمل دون التحرر من الاستبداد.
بعد ثورة يناير، فوجئتُ في ميدان التحرير بحديث حول العودة إلى دستور 1923. كان ذلك الدستور القديم حديثًا حيًا في حلقات الثورة، وكأن التاريخ لم يَمُت، بل يُنادي فينا أن نُكمل رسالته.
لم يكن ذلك اليوم في أبريل البعيد، مجرد إعلانٍ عن وثيقة، بل كان إعلانًا عن يقظة شعب، أراد أن يُلزم من يحكمه، لا أن يُبايع. أراد أن يؤسس دولة لا تدين للحاكم، بل تحتكم للدستور.
جاء دستور 1923 في زمنٍ كانت فيه أوروبا تنفض غبار الحرب العالمية، وتعيد ترتيب خرائطها بالبندقية، لا بالحبر. لكن مصر، بثورتها ووعيها، اختارت أن تبني دولتها بالمادة الدستورية، لا بالمدرعة العسكرية.
أراد هذا الدستور أن يعيد ترتيب موازين السلطة: ملكٌ بلا قداسة، يملك ولا يحكم حكومةٌ تحت الرقابة، برلمانٌ صاحب سيادة، شعب يختار من يمثله ومن يحكمه
١٩ أبريل ١٩٢٣ يومًا يُشبه الأساطير ، لكنه خرج من رحم ثورة 1919 تحمل جراحها، وأحلامها، وأملها في دولة دستورية تُولد من الناس ولأجلهم. لم يكن ذلك اليوم مجرد مناسبة لإعلان وثيقة، بل لحظة فريدة صنع فيها الشعب أول دستور حديث في تاريخه، دستور لم يُكتب بإملاء القصر أو وصاية الاحتلال، بل بإرادة شعبية نضجت بطعم و دم الثورة.
كتبنا دستورنا بأيدينا، في زمن كانت فيه شعوب كثيرة لا تزال تُحكم بالمراسيم، وتُقاد بالعصا.
سبقت مصر بهذا الدستور عشرات الدول التي كانت تتلمس طريقها نحو دولة القانون والمؤسسات.
سبقنا إسبانيا التي لم تعرف النظام الجمهوري المستقر إلا بعد الحرب الأهلية، وسبقنا ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية،
بل سبقنا حتى بعض ولايات أمريكا التي لم تكن قد أرست بوضوح الفصل بين السلطات حين كنا نحن نكتب – وبالعربية – دستورًا يربط السلطة بالرقابة، والحكم بالمحاسبة.
دستور ١٩٢٣ جاء ليرسي معالم دولة مدنية برلمانية حديثة، قوامها الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية التعبير والصحافة، والمساواة بين المواطنين، والانتخاب الحر، والتمثيل النيابي الحقيقي.
اختار دستور 23 –عن وعي سياسي نادر – النظام-البرلماني لا الرئاسي، ليقيد السلطة التنفيذية بإرادة الأمة، عبر ممثليها في البرلمان، الذين لا يملكون فقط التشريع، بل مراقبة الحكومة،بل وسحب الثقة منها.
بهذه الروح، نص الدستور في مادته (١٠٩) على أن “الملك يُباشر سلطاته بواسطة وزرائه”، مما كان إعلانًا صريحًا بنهاية الحكم الفردي، حتى وإن أبقى على صورة الملكية الدستورية. كما نص في المادة (١٠٥) على أن “كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته”، وفتح باب المساءلة البرلمانية والرقابة الشعبية، في وقت كانت فيه بريطانيا ذاتها لا تمنح هذا الحق لمستعمراتها. وصفه المفكر القانوني الفرنسي إدمون بونيه بأنه “أكثر الدساتير العربية نضجًا وتقدمًا”، بينما كتب طه حسين يقول: “كان هذا الدستور بداية إدراك المواطن المصري أنه مواطن، له رأي، وله صوت، وله دولة تُحاسب، لا تُعبد”.
أما عبدالرازق السنهوري، فقد اعتبره “الدستور الذي وُلد من ضمير الأمة لا من فتاوى الحاكم”، وقال في واحدة من مقالاته الشهيرة عام 1936: “هو أول محاولة لتوطين فكرة السيادة الشعبية في وادي النيل، لا بوصفها حيلة قانونية، بل كفلسفة حكم”.
أما زعيمنا سعد زغلول، الذي حملت الثورة اسمه، فقد قال كلمته الخالدة بعد صدور الدستور: “لقد كتبنا هذا الدستور في الشوارع قبل أن نكتبه في السطور، ومن لا يرى الشعب سيدًا، فلا يستحق أن يحكمه”.
لا يمكن فهم قيمة دستور 1923 إلا بمقارنته بالدساتير المصرية الأخرى. فـ دستور 1956 كان دستور الانقلاب، ودستور 1971 جاء في ظل القمع والانفراد، وتم تعديله مرات عديدة لخدمة شخص واحد. أما دستور 2014، فقد كُتب في زمن الخوف، وأُقر تحت التهديد، وعُدّل لاحقًا ليُمدد للسلطة ويقيد الحقوق.
وعلى النقيض، كان دستور 23، دستورًا حقيقيًا ، لا يُكتب تحت حراب العسكر، ولا يُستولد من رحم الطوارئ. لم يُلغِه إلا الذين خافوا من نوره، فعُلّق في الثلاثينيات، وأُعيد لاحقًا بفعل ضغط شعبي، ثم طُمست ذكراه بعد انقلاب ١٩٥٢، كما تُطمر الشواهد الحقيقية كي لا تفضح الزيف.
اليوم، وبعد 102 عامًا من صدوره، لم تعد الفكرة أن نترحّم على الماضي، بل أن نستعيد معناه. لقد كتبنا في ١٩٢٣ دستورًا كان يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو دولة مدنية حديثة، لكننا لم نحسن حمايته، وتركنا المِلْك يعلو فوق الدستور، ثم تركنا العسكر يدفنونه ليصعدوا فوق رماده إلى سلطة لا تُقيدها قوانين.
الوضع الدستوري الراهن في مصر لا يُقارن بأي حقبة سابقة في الرداءة والتفريغ. فالدستور الحالي يُشرّع تغوّل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية، ويُمكّن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية، بل ويُفرغ مبدأ الفصل بين السلطات من مضمونه. كل ذلك تم تحت عنوان “الاستقرار”، بينما الحقيقة هي أن السلطة المطلقة لا تجلب إلا الفساد المطلق.
هل آن أوان العودة إلى الدستور لا إلى الدولة الأمنية؟ هل يمكن أن نستعيد روح 1923 بدل أن نُعيد إنتاج كابوس ٥٢؟
إن دستور 1923 لم يكن مثاليًا، لكنه كان الأكثر اتزانًا وعدالة، لأنه لم يُصَغ في دهاليز الأجهزة، بل خرج من حناجر الناس. وهو لا يزال، حتى اللحظة، الدليل الوحيد على أن المصريين إذا أُتيح لهم أن يكتبوا مصيرهم، فلن يكتبوا الاستبداد أبدًا.
يا سادة.. لا مستقبل بلا مرآة، ولا نهضة بلا دستور عادل. والعدل لا يأتي من النصوص، بل من الإرادة. فكما كتبنا ذات يوم دستورًا بأصابع الحرية، يمكننا اليوم – إن شئنا – أن نعيد لمصر بوصلة الحق، ونُسكت خُطباء الطغيان، ونُحيي صدى صوت كان يهتف يومًا:
“الشعب هو السيد، والدستور هو الضامن، والوطن هو المآل.”