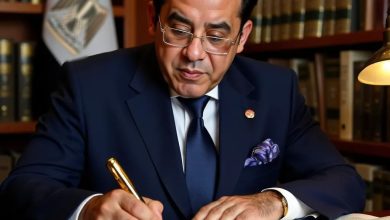لم تكن الغربة في بعدها الجغرافي هي الجرح الأعمق، بل تلك الكلمات التي تُرسل كطعنة باردة من سلطةٍ قرّرت أن تنفيك من الذاكرة قبل أن تنفيك من الجغرافيا. سلطةٌ تُمارس أقصى درجات القسوة، لا بالسجن، بل بالمعنى… لا بالنفي، بل بإشاعة أن لا عودة لك، وأنك ستموت وتُدفن خارج الوطن كعقوبة رمزية نهائية، لمن تجرأ أن يقول: لا.
بين 2013 و2022، كنتُ شاهدًا على ذلك الوجه البشع لمنظومةٍ لا تملك أدوات الرد، فتستنجد بالسُخف، وتستنبت الذباب الإلكتروني من حوائط العجز والخراب، ليردد في كل مرة، ذات العبارة الخاوية:
“يكفي أنك ستموت وتُدفن خارج تراب وطنك!”
في البدء، كنت أضحك… لا استهزاءً، بل دهشةً من هذا العجز الفج. وكنت أقول لنفسي:“وماذا يضير الضحية بعد ذبحها… سلخها؟ أو دفنها؟ كلنا ضيوف في هذه الدنيا، وما على الضيف إلا الرحيل.”
وكنت أردد:
“كُن عابرَ سبيلٍ في الحياة… واترك خلفك كل أثرٍ جميل.”
السخافة في تلك “المعايرة” لم تكن تؤلمني، بل تُدهشني من عمق التفاهة، وسطحيّة الكراهية التي تتحول إلى برنامج إعلامي يومي، يُقدّمه – ويا للعجب – عمرو أديب، بصوته المُتخم بالأوامر، ولسانه المشغول بالتسعير.
كتبت له يومًا رسالة، لم أرسلها. فقد سبقني بحجبه لي على “واتساب”، بعد أن عجز عن الرد على نقدي لمواقفه المتقلبة، وتجاوزاته التي تُباع على الهواء، كأي سلعة فاقدة الصلاحية.
كنت أود أن أُهديه فيها حكاية حقيقية عشتُ فصولها، تُعرّي من يُراهن على الموت كأداة للطمس السياسي…
كنت أود أن أُهديه فيها حكاية حقيقية عشتُ فصولها، تُعرّي من يُراهن على الموت كأداة للطمس السياسي.
حين قرر أنورالسادات إعادة الحياة الحزبية عام 1977، أبدى – على استحياء – رغبته في عودة حزب الوفد، بل ولمّح إلى تمنيه زعامته.
لكن فؤاد سراج الدين لم يُشجّعه، وواجهه الوفديون بجفاءٍ سياسي محسوب.
غضب السادات، فشنّ حملة ضارية على الحزب، وعندما رأى التفاعل الجماهيري مع فكرة عودته، بدأ في التراجع، حتى اتخذ الحزب – بتحدٍ وطني – قرارًا بتجميد نشاطه احتجاجًا، في واقعة أحزنت الرئيس… لكنها كانت صائبة.
بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981، تقدّمنا بطعنٍ قضائي ضد قرار التجميد، ونجحنا في استعادة شرعية الحزب.
رشّحنا أحمد_طه، النائب اليساري، في دائرة الساحل، فرفضت الداخلية أوراقه.
عدنا إلى القضاء، الذي أقر بحق الحزب في الترشّح، وألزم الدولة بقبول أوراق مرشحيه.
أوكل حسني مبارك إلى رئيس وزرائه فؤاد محيي الدين مهمة التشاور مع رفعت المحجوب ووزير الداخلية بشأن التنفيذ، وخلصوا إلى قناعة أمنية باهتة:
“فؤاد باشا عجوز… وسيموت قريبًا، وسيموت معه الوفد.”
ولكن… سخرية القدر لا تخيب!
فؤاد محيي الدين توفي إثر أزمة قلبية بعد إبلاغه بإقالته.
حسن أبو باشا نجا من محاولة اغتيال، لكنه خرج من المشهد.
رفعت المحجوب قُتل بالخطأ في عملية اغتيال بوسط القاهرة.
أما فؤاد سراج الدين، الذي راهنوا على موته، فقد شيّع جنازاتهم جميعًا… وظل حيًّا حتى عام 2000، يُمارس السياسة واقفًا كما تعوّد.
أردت أن أروي لـ عمرو_أديب هذه القصة عندما قال باستخفافٍ:
“ستُدفن خارج تراب وطنك.”
كأنّ الموت في الوطن وثيقةُ انتماء، والموت في المنفى خيانةٌ موثقة!
تذكرت حينها نصيحة جمال الدين الافغاني لـ عبدالله_النديم:
“افعل ما تراه صوابًا في غربتك… إلا أن تموت غريبًا.”
فرد عليه النديم:
“أرض الله واسعة… وأوسع من ظلمهم.” قضيتُ سنواتٍ أبحث عن قبر عبدالله النديم في إسطنبول… فلم أجد شاهدًا، ولا حجرًا، ولا نقشًا.
علمت لاحقًا أن عائلةً دفنته في مدفنها المشترك، دون اسم، دون ضوء… كأنهم أرادوا أن يموت في الظل كما عاش.
والنديم – لمن لا يعرف – ليس مجرّد رمزٍ من رموز الصحافة الوطنية والثورة العرابية، بل هو ضمير مصر في القرن التاسع عشر.
توفي في إسطنبول يوم 10 أكتوبر 1896، عن 54 عامًا، بعد صراع مع داء الرئة. وقد دُفن في مقبرة “يحيى أفندي” في حي بشكتاش، وهي مقبرة عثمانية عريقة تضم بين جنباتها سلاطين ووزراء، لكن دون أن يُميز شاهد قبره أو يُدوَّن اسمه.
رغم أن السلطان عبدالحميد الثاني أمر بأن تُشيّع جنازته بموكب رسمي مهيب، تقدمه فرق من الجيش والشرطة وطلبة المكتب السلطاني، وحضره الافغاني وعبدالرحمن الجازولي…
إلا أن قبره اليوم لا يُعرف، ولا يُزار، ولا يُدلُّ عليه، كأنما خُطط أن يظل صوته غائبًا حتى بعد موته.
وقد كتب عنه يحيى حقي لاحقًا، وقال:
“أطالب بعودة رفات عبد الله النديم من إسطنبول إلى مصر، إلى ضريح يليق به، ويليق بنا…”
وما زال المطلب معلقًا منذ قرن وربع…
نداءٌ منسيّ، ورفاتٌ منفية، وذاكرةٌ تختبر وفاءنا.
مات النديم منفيًّا، كما مات الكواكبي في حلب، والأفغاني في إسطنبول. كلهم لفظهم الوطن حين صرخوا بوجه المستبد.
كلهم دُفنوا غرباء… وعاشوا خالدين.
أما طلعت حرب، فقد مات في أوروبا، مُطارَدًا، محاصرًا، بعدما أغلقوا مصانعه، وضيّقوا عليه حياته. ألا تستحق رفات هؤلاء أن تعود للوطن؟
ألا يستحق الوطن أن يسترد رموزه… لا ليُكرّمهم فقط، بل ليُداوي جرح نكرانه لهم؟
إنني لا أطالب برد اعتبارٍ لي، بل لنديمٍ صرخ فأسكتوه، ودفنوه فأنكروه. أطالب بوطن لا يُعادي أبناءه إذا اختاروا طريقًا غير طريق السلطان.
أطالب بعودة مغتربٍ عزيز…
فالأرض كل الأرض بطنها سواء؛ هنا أو هناك. ما الفرق؟ التراب هو هو، طاهرٌ حيث كان، ورعية محمد أمة واحدة، والإسلام يكره قلقلة الميت عن حدّه.
ومع ذلك، لا أخشى أن يكون مطلبي بدعة معانقة للضلالة. ماذا أفعل وأنا وريث حضارةٍ تبدأ بالقبور قبل البيوت؟
القبر أكثر دوامًا، وأغنى أثاثًا، وأعلى مقامًا من البيت. أشقّ الغربة… غربة الرفات لا الأحياء.
أذكر فلاحةً كانت تأتي كل عيد من البساتين على ظهر حمارها، إلى القرافة، تعصب عينيها وتمشي بلا دليل… لكنها كانت تهتدي بأنفها لا بعينها إلى قبر عزيزها، وسط المقابر التي طمرته دون علامة، كأن الرائحة دليل، وكأن الحب هو البوصلة.
وإن كُتب لي أن أُدفن خارج حدود مصر، فليكن هذا الوطن أوفى لمن سبقني…
فلعلّه يتعلّم أن الاختلاف ليس خيانة، وأن الغربة ليست عارًا، بل بعض الكرامة.
قد نموت في منفانا، لكننا نحيا في ذاكرة الأوطان… ما دمنا قد عشنا بكرامة.