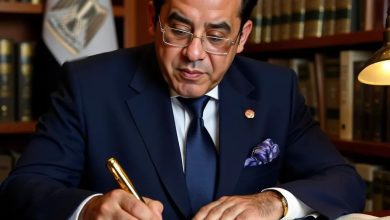الدكتور أيمن نور يكتب: الصراع على الرئاسة في مصر .. عمرو موسى حكاية لم تكتمل

في كل سيرة سياسية، فصل ناقص لم يُكتب، وحكاية تظل مفتوحة رغم اكتمال فصولها على الورق.
وحكاية عمرو موسى، في سياق الصراع الطويل على الرئاسة في مصر، كانت من تلك القصص التي بدأت بملامح لامعة، ثم تراجعت أمام مفترق التوقيت والخذلان، والحصار.
عرفته عن قرب، لا كسياسي فحسب، بل كإنسان يتقن فن التوازن بين الصرامة والأناقة، وبين الحزم والدبلوماسية.
كان أول لقاء لي به، في شتاء عام 1995، حين رافقته إلى غزة، لحضور افتتاح أول برلمان فلسطيني على الأرض. كانت رحلة من النوع الذي يُكتب في المذكرات ، لا لحدثه فحسب، بل لما يختزله من رمزية.
توقفنا على بوابة معبر رفح، وعُلّق دخولنا، نحن وفدًا صغيرًا مكوّنًا من أربعة رجال. عشرون دقيقة من الانتظار الصامت، قبل أن يتكلم موسى بنبرة حاسمة، قائلاً: “أبلغوا قيادتكم… أن أي مسؤول إسرائيلي يهبط القاهرة، لن يغادرها قبل عشرين دقيقة”.
ظننتها لحظة انفعال، لكنها كانت قرارًا. و بعد أيام، تأكدت حين قرأت في الصحف الإسرائيلية أن نتنياهو أُجبر بالفعل على الانتظار في مطار القاهرة للمدة نفسها.
عرفت يومها أن الرجل لا يقول إلا ما ينوي، ولا ينوي إلا ما يستطيع.
لم تكن تلك الواقعة إلا عنوانًا مبكرًا لحكاية أكبر، بدأت داخل النظام نفسه. كان موسى وزيرًا للخارجية في واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا وغموضًا. ومع منتصف التسعينيات، بدأ اسمه يتردد في الشارع، في الصحافة، في مقاهي المثقفين، كبديل مدني، عقلاني، له كاريزما الدولة وخيال الجمهور.
كان حلماً جميلاً غير مكتملة ملامحه
امتلك الرجل أسلوبًا مختلفًا. لم يتكلم بلغة السلطة، بل بلغة الشارع. لم ينكفئ على البروتوكول، بل خرج به إلى قلب المعركة السياسية، خاصة في مواقفه من إسرائيل، ومن الهيمنةـالأمريكية على المنطقة.
وهنا بدأت مشكلته الحقيقية. لم يحتمله النظام، ولا أجهزة الدولة التي كانت تُعد المشهد بهدوء لتوريث الحكم.
كان جمال مبارك مشروعًا هشًا، لا يحتمل منافسين.
وكان موسى منافسًا لا يطلب ذلك، لكنه يخطف الأضواء دون أن يقصد. وهكذا بدأت خطة إقصائه… خطوة بعد خطوة.
تم تقليص صلاحياته، إبعاده عن الاجتماعات، ثم ترحيله السياسي إلى جامعة الدول العربية، التي بدت –آنذاك– كمقبرة دبلوماسية أُعدت بعناية.
في الظاهر، كانت ترقية.
في العمق، كانت عزلًا.
وفي الواقع، كان قرارًا بدفن الحلم الذي بدأت ملامحه تتشكل في عقل موسى، وفي وعي الناس معًا.
لكنّ عزله لم يقتله سياسيًا.
بل منحه، على نحوٍ غريب، مساحة للتأمل في احتمالات المستقبل.
وبعد سنوات الصمت، انفجرت ثورة يناير، وتبدلت خريطة السياسة.
عاد اسم موسى للواجهة، كأحد الوجوه المدنية الممكنة. اقتربنا أكثر في تلك المرحلة، وتشاورنا، وتوافقنا على كثير من التفاصيل.
عندما تم استبعادي من انتخابات الرئاسة عام 2012، كانت الهيئة العليا لحزبي غد الثورة تصوّت على مرشح بديل، فحصل موسى على 50% من الأصوات
لكن الحقيقة أن اللحظة لم تكن لحظته، فلم تكن شعبيته كما كانت في التسعينيات.
فقد طالته سهام النقد، بعضها عادل، ومعظها جائر. اتُهم بأنه امتداد لمبارك، وبأنه من “الفلول”، رغم أن مواقفه – في رأيي – كانت دومًا أكثر وطنية من كثيرين تزيّوا بلباس الثورة.
في واحدة من محطات هذا التقارب، بعد لقائي بالرئيس محمد مرسي، عرضتُ على موسى فكرة انضمامه لحكومة ائتلافية كنائب أول لرئيس الوزراء مسؤول عن العلاقات الخارجية. لم يتردد. لم يناور كما فعل غيره. بل وافق بصدر مفتوح. لكنّ الرياح جرت كما أرادت أيادٍ أخرى، داخلية وخارجية، لم ترغب في حضوره، لا داخل الحكومة، ولا على بالو مقاعد القرار.
أتذكّر مأدبة غداء جمعتني بالمجلس العسكري، برفقة المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، وسيد البدوي. سأل الأخير عن توقعات الانتخابات، فأجاب عنان مباشرة: “الإعادة بين مرسي وأبو الفتوح”. وحين سأل عن موسى وأحمد شفيق، قال عنان: “مستحيل”. لم تكن قراءة تحليلية، بل قراءة لخارطة أُعدّت سلفًا، حيث يُقصى من يُقلق، ويُقرّب من يُؤمن له استقرار المصالح.
وكان للموقف الإقليمي كذلك دور في إقصاء موسى. خاصة أبو ظبي، التي احتفظت تجاهه بحالة من الجفاء، بسبب سخريته العلنية من مبادرة الشيخ زايد الخاصة بالعراق، في فترة كان فيها عمرو موسى لا يخشى إعلان الموقف ولو بصيغة السخرية.
وأشهد، بأمانة، أنني أحببت عمرو موسى منذ سنوات، ولم تغادرني تلك المشاعر في يوم من الأيام.
أحببت فيه السياسي الواعي، والإنسان الرقيق، والدبلوماسي الذي يحمل في جعبته تاريخًا من التوازن والاتزان. مدين له بتشجيعه لي في محطات مفصلية، وبثقته الواسعة التي عبّر عنها أكثر من مرة، أمام جمهور متنوع، حتى في حضور من يحملون مشاعر سلبية تجاهي، أو تجاهه هو شخصيًا.
حضرنا معًا عشرات الاجتماعات، وكنا نتوافق، ربما بحكم خلفية فكرية متقاربة، وربما بسبب اعتبارات إنسانية عميقة لم تُكتب.
ربما يرى البعض – وربما معهم بعض الحق – أن اختياره في 2012 لم يكن موفقًا في توقيته، وأن اللحظة كانت تحتاج وجهًا آخر، أو نَفَسًا ثوريًا مختلفًا. وربما لو تم هذا الاختيار قبلها بسنوات، لوجد قدرًا أكبر من التوافق والإجماع. وربما يقول البعض – وأنا أوافقهم جزئيًا – إن سن عمرو موسى، وقد تجاوز الثمانين في عام 2025، لم يعد يسمح له بخوض انتخابات رئاسية جديدة.
لكنني ما زلت أؤمن أن لموسى دورًا آخر. لا رئيسًا، بل “عرّابًا” و منقذا لما تبقي من حزب الوفد، ومُحييًا لروحه التي أزهقت.
فضلا أني ما زلت أراه مناسبًا، وربما أكثر من أي وقت مضى، لدور جامع في مرحلة انتقالية، تُحتاج فيها إلى رجل دولة، له من الخبرة ما يكفي، ومن الحضور ما يوازن، ومن العلاقات ما يُطمئن الجميع* .
عمرو موسى … حكاية لم تكتمل. لكنه أيضًا، لم يخرج من المشهد. فالحكمة لا تُقاس بالعمر، بل بالتجربة. والحنكة لا تُحدّها التباينات في بعض الأحيان في المواقف
أمد الله في عمر هذا الرجل …
د. أيمن نور
المرشح الرئاسي الأسبق –
رئيس حزب غد الثورة الليبرالي
و رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية
( غدا الحلقة الرابعة من أوراق الصراع على رئاسة مصر لغز عمر سليمان )