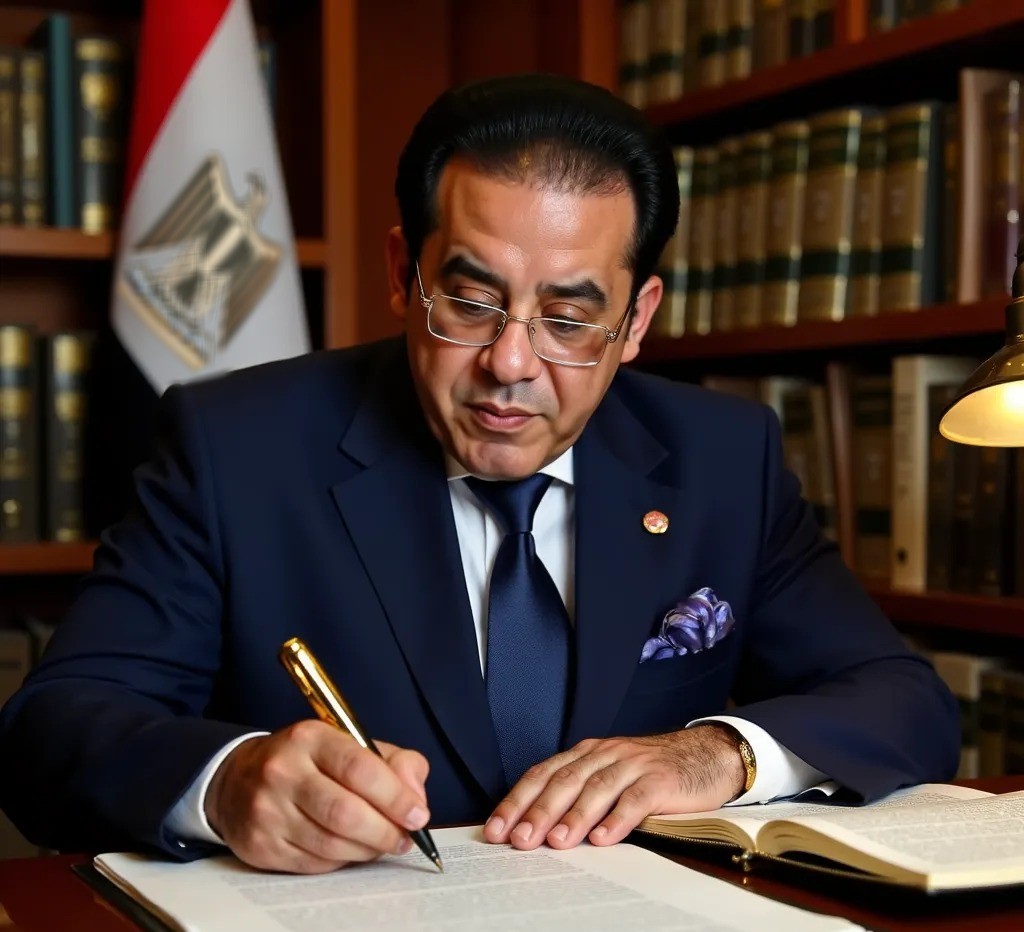
في ليلة الرابع والعشرين من يوليو، عام ٢٠١٣، وقبل موعد السحور بقليل، دق جرس الهاتف. كنت في بيتي السكندري، على شاطئ ستانلي. كانت المدينة تستعد لليلة أخرى من ليالي الصمت.
جرس الهاتف شقّ السكون، كصرخة مولود يُنتزع من رحم أمه. أدركت من توقيت الاتصال، وشخص المتصل، أن الموجة القادمة ليست كسابقاتها…
لم تكن المكالمة حوارًا، بل كان قرارًا (معنا أو ضدنا). لم يُمهلني صوت المتحدّث مساحةً للتفكير، للتفاوض، حتى للدهشة، ولا فرصة لالتقاط النفس: “إما الطاعة… أو الغياب”.
لا خيار، لا رأي، لا حق حتى في تحديد ساعة الرحيل أو ملامح الطريق. كُتبت لي تذكرة سفر، لا بمداد، بل بإملاء الخوف، ومُذيّلة بختم “الصمت أو الرحيل”.
في الطائرة، لم أكن راكبًا كسائر الركاب. كنت مشروع سؤالٍ كبير، تطرحه عيون من صادفتهم على نفس الطائرة ويعرفونني وأعرفهم – مثل رجل الأعمال صلاح دياب، والإعلامي توني خليفة – الذي كاشفني في لقاء لاحق في بيروت، أنه كان على يقين، ونحن في الطائرة، أن عودتي إلى القاهرة لن تكون قريبة.
غادرت… لا لأني أردت، بل لأنني أصررت أن أبقى على قيد الكرامة. فالرحيل – أحيانًا – هو الشكل النبيل للبقاء.
رحلتي صباح يوم 25 يوليو 2013، كانت المرة الأولى التي أغادر فيها وطني، دون أن أحدد يوم وساعة العودة. لكنها لم تكن المرة الأولى التي أواجه فيها آلة الظلم وأتذوق مرارتها.
عرفت – لخمس مرات – في حياتي مذاق القيود، ورائحة الزنازين، وصوت القضبان، حين تتكلم نيابة عن القانون. لكني لم أعرف زنازين الغربة عن الوطن من قبل.
في الوطن، حين ترفض السجود، تُتّهم بالهرطقة. وحين ترفض التهليل، تُوصم بالخيانة. لكني تعلمت في حياتي، أن الصمت في حضرة الظلم، ليس حيادًا، بل خيانة للحق.
تهمتي الحقيقية والوحيدة، في كل مرات اعتقالي، كانت “الكلام”. نعم، الكلام في أزمان الخرس، والحلم في زمن الكوابيس. لم أهرب يومًا من عدالة، ولو كانت مهزلة.
لم أختبئ من محكمة، أو حتى مقصلة. ولم أحمل في حقيبة سفري، غير أوراق حلم بالـ حرية مؤجَّل، وصوت ضمير لم يُفلحوا يومًا في إسكاته.
حين احتضنتني بيروت، لعامين، ثم إسطنبول، لعشرة أعوام، لم يكن المنفى مكانًا، بل امتحانًا.
12 عامًا – حتى الآن – لم أغب فيها عن مصر، بل كنت أقرب إليها من أي وقت.
أراها في عيون أمي، كلما قرأت سورة “يس” على روحها، وفي وجدان أبي، كلما تذكرت دموعه الصامتة وهو ينظر إليّ – نظرة الوداع – بعد اعتقالي فور إعلان نتائج انتخابات الرئاسة 2005، الأولى في تاريخ مصر، والتي حللت فيها – ثانيًا – من بين عشرة مرشحين.
لم تكن مصر، يومًا، في عيني مجرد جواز سفر، أو خريطة معلّقة، أو علمًا خلف طاولة مكتب.
مصر رعشة تُصيب القلب إذا ذُكرت. هي الأم التي – وإن قسَت – لا تكفّ عن الحضور.
وحدهم الحمقى من يظنون أن الحاكم هو الوطن، وأن غروب الشمس يُلغي فكرة الشروق.
فالأوطان، لا تموت في قلوب المؤمنين بها، وتنبت فيها الحياة حتى من جدران الزنازين.
الحرية ليست ترفًا، بل شرط وجود. والدولة التي تهاب الكلمة، هي دولة بلا ثقة. وكل الأنظمة، هي مجرد فاصلة في جملة شعب إذا قرر أن يحيا.
لم أخرج نصيرًا لفريق ضد آخر، كما روج البعض، بل حاملًا لقضية أوسع من الاستقطاب، وأعمق من المعارك الصغيرة. خرجت لأن من بالداخل لم يُسمح له بالخروج عن صمته.
لم ندّعِ النصر، ولكننا – يقينًا – لم ننهزم. فكل نزال من أجل الحرية، يكفي أن تواصل الوقوف فيه لتُبقي المعركة حيّة.
كفي أن تُشعل شمعة في زمن الظلمة، وأن تهمس بكلمة في صمت الموت، لتُسجَّل في دفتر التاريخ كمَن قاوم، ومَن حاول ولم يتوقف عن المحاولة.
الذين ذاقوا الغربة، لم ولن يطلبوا يومًا امتيازًا. بل بحقّ العودة، لوطنه دون خوف أو عقاب. فهو حق، ليس مضطرًا معه أن يُجمّل القبح، أو يُرمّم الخراب بطلاء الزيف.
فإمّا أن نكون أحرارًا… أو لا نكون. فـالوطن ليس أرضًا… بل كرامة تُصان، وحق يُحترم، ومستقبل يُبنى على الحقيقة لا الوهم، وعلى الحرية لا على الخضوع.









