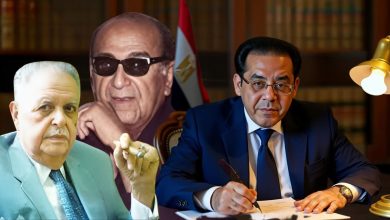“حاسس إن البلد بقت بتاعتنا، وإننا نقدر نعمل للبلد حاجات كتيرة، ومش بعيد أسامينا وصورنا تتعلق في
الشوارع”.
كان هذا جزءا من حوار مع صديقي ونحن نسير في الشوارع فرحين برحيل مبارك، تشعر كل ذرة في أجسامنا أننا أصبحنا نعيش بكرامة وحرية وسنكون فاعلين لخدمة بلادنا.
بدأت الأمور سريعا في التعكر والتغير، لا نفهم حقيقة ما تقوم به المؤسسة العسكرية بعد أن أيدت رغبات الشعب والشارع -أو هكذا فهمنا-، لكنها تدريجيا تعيد ممارسات القمع والتخويف والانتهاكات.
لِمَ يتصارع الساسة ويختلفون ولا يتفقون في هذه اللحظات الكبرى؟ لم ظهر الشقاق والشجار والتشكك بينهم سريعا؟ لم قُمِع الناس وقُنص بعضهم بقناصة محترفة بعضهم في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى؟ لم تلكأت المؤسسة العسكرية في إنجاز الانتخابات؟ ولم تشككت النيات حولها؟ لم أصبح الإخوان -وهم في الحكم- أكثر ضعفا لا يتمكنون من إيقاف الأزمات والضغوط وبث الثقة وتقوية التحالفات؟ لِمَ لَمْ يدرك الرئيس مؤامرة الانقلاب إلا بعد فوات الأوان؟
ولماذا أصبح عاجزا عن الفعل والتصرف؟ لم كان الغضب من الإسلاميين عند بعض الساسة والإعلاميين وناشطين أكبر من ضرورة حماية الديمقراطية الوليدة والدفاع عنها؟ لم يهلل بعضٌ منّا للقمع والقتل وانتهاك الكرامة ويحسب أنه آمن لن يطوله ذلك يوما ما؟
مرت سنوات وأحداث وأزمات وكوارث، ومرت وعود وآمال أنّ مصر ستكون -بحق- أم الدنيا، وأنّ الشعب رُزِق برئيس حقيقي سيحنو عليه، وأنه في وقت قصير سيشعر الناس بالغنى والقوة ربما بعد ٦ شهور أو سنتين أو سنة أخرى أو عدة سنوات، لكن أخيرا أعلنها السيسي أننا شبه دولة ولا يمكن حل مشكلات الفقر والتعليم، لكن مع ذلك نحن أفضل وأحسن وأجمل وأقوى (وفي حتة تانية) بفضل مشاريع الكباري والعاصمة الإدارية و(هاشتاج) الجمهورية الجديدة الذي يُغرِق القنوات الفضائية المصرية، ومع هذا الإغراق في الأمل يستفيق الناس على انهيار للعملة، وارتفاع معدل التضخم ومعه الأسعار، وتدني الخدمات، وأخيرا وللأسف ليس آخرا انقطاع الكهرباء في ذروة فترات الحر والانشغال بامتحانات الثانوية العامة.
لكنّ القهر الحقيقي في العجز عن حماية أبرياء من القتل والتعذيب، آلاف من الشباب والشيوخ والنساء يُحتجزون في أماكن غير آدمية، يتعرضون للإذلال والتنكيل في كل لحظة داخل الجدران الأسمنتية الظالمة، لا يهم حق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة والقضاء العادل النزيه، ولا حق الرعاية الصحية ولا احترام السن والنساء، حق الزيارة يحتاج نضالا، وحق كتابة الخطابات يحتاج جهادا، وحق الاعتراض على التلفيق والتزوير والتعذيب والتنكيل
معلق إلى أجل غير مسمى، هل استطعنا العيش حين سكتنا عن هذا القهر؟
لكن ماذا يفعل المقهورون؟
الصبر والتصبر ومحاولة التكيف مع الواقع تثبت يوما بعد يوم أن الأسوأ دائما قادم، وأن محاولة النجاة الفردية لا
يمكنها أن تحدث حين تغرق سفينة البلاد.
ماذا يفعل المقهورون؟
ربما يغضبون من بعضهم، يصرخون يتجادلون، لمَ فعلتَ كذا؟ ولم لم تفعلْ كذا؟ لم تركتني أو خذلتني أو خنتني أو خدعتني؟ لمَ لمْ تأخذ نصيحتي أو تحترم غايتي؟
ماذا يفعل المقهورون؟
ربما ينعزل بعضهم عن بعض، يبحث كل واحد منهم عن منطقة أمان بعيدة عن الضغوط (وحرقة الدم والأعصاب)، وربما بعيدا عن الجدال العقيم أو تكرار الأحاديث والأمنيات والتوقعات.
هل لدى المقهورون أمرٌ غير التصبر والغضب والانسحاب؟
لا أدّعي إجابة حاسمة، فالواقع يزداد ضيقا، وداخل المعتقلات يعيشون من سيء لأسوأ، حتى السوء لا ينتهي بخروجهم، بل ينتقلون إلى دوامة جديدة من فقدان وظائفهم ومصادر دخلهم وآثار جسدية ونفسية وملاحقات جديدة لا تتركهم آمنين.
نعم يُعبّر رجل الشارع البسيط (عايزين نعيش)، والتي تعني دع الملك للمالك وأجهزة الدولة أيضا، لكن ذلك لا يفلح الآن، لم يعد يحمينا من قطع الكهرباء، ومن الفساد وتبعاته التي تفوق الاحتمال. الحقيقة أننا لم نعد نمتلك من دولتنا شيئا، حتى الأرض قد تُسحب منا بالقوة الجبرية كما حدث في النوبة وسيناء أو الورّاق، إننا لا نملك إلا ما بقي من إنسانيتنا، نملك بعضنا، ولا ينبغي أن ننتظر من يحنو علينا بوعود زائفة كاذبة، أو ننتظر رئيسا
ملهَما أو زعيما مخلِّصا أو مستبدا عادلا أو خليفة زاهدا، يبدو أنه لن يأتي أحد.
نحن بحاجة للعيش بروح العائلة الواحدة الكبيرة، منا القوي والضعيف، والصغير والكبير، والمتسرع والهادئ، والمجتهد والكسول، والتاجر والموظف والمعلم والطبيب والصحفي إلخ، منا من يحب نفسه حبا زائدا أو يحمل تطلعات أكبر من حدّها، ومنا من ينتقص من ذاته وقدراته، ومن يرى نفسه أكبر من الجميع أو أقل، لكن كلنا عائلة واحدة مقهورة بفُرْقتها. ربما الآن لا نملك إلا حلا واحدا أن نحمي هذه العائلة، ونقلل نزيفها وفُرقتها، أن نساعد بعضنا على التعلم والتطور والكسب الحلال، أن نطوّر أفكار الدعم والمساندة، ولا نضع حواجز بسبب خلفية أو مرجعية أو لون أو جنس، وألا يكون الاختلاف بيننا أكبر من قهرنا.
نحن بحاجة إلى مناخ من التعاون والتراحم والحوار الفعّال، نحن بحاجة إلى دعم (الغلابة) والأكثر تضررا وعرضة للبطش والقمع والملاحقة، يبدو أننا لا نملك إلا عائلتنا الكبيرة داخل مصر وخارجها، فإن لم نسمع أنفسنا فمن سيستمع. نحن بحاجة إلى دعم علمائنا وباحثينا الذي يفكرون ويحللون ويستخلصون، فالجادون منّا يكابدون الحياة وضيق السبل ولا يجدون ما يعينهم على البحث والتطور وتبصير الناس؛ بل ربما وجدوا مزيدا من العنت والتضييق، نحن بحاجة إلى تقليل الاستنزاف وعدم تعجل إلقاء النفوس إلى التهلكة، دون أن نبخس أي تضحية حقها.
نحن بحاجة إلى روح جديدة، تبدأ بعودة العلاقات والصلات بين الجيران والأصدقاء في الحي الواحد والمدينة الواحدة، والداخل والخارج، فلنتواصل من أجل العائلة، يشدُّ بعضنا أزر بعض ويُصبّر بعضنا بعضا، ونعطي رسالة هادئة لسياسات القهر أننا -وإن عجزنا- لا زلنا عائلة واحدة، يدا واحدة على من سوانا، صلات يجب أن تبدأ فورا في تجاوز الخوف، وتبادر بالاعتذار عن غلبة الخوف أو سوء الظن أو الوقوع في فخ الخداع.
داخل العائلة منا باحثون يحتاجون بل يجب أن يمدّوا خطوط التواصل العلمي الموضوعي، ليتقوّى بعضهم ببعض، دون تعجل الإقناع والتوافق، فبقاء المختلفين قد يكون أقوى من وهن المتفقين وسرعة فنائهم. داخل عائلتنا ناشطون سابقون وساسة خاضوا ما خاضوا من تجربة -أحببناها أو كرهنا-، فلا أقل من مناخ هادئ لتسجيل التجارب واستخلاص الدروس والعبر، دون الإصرار على تعجل تجارب جديدة، على الأقل لمنح الأجيال القادمة خلاصات التجارب دون وصاية أو ضغوط.
داخل العائلة شباب وفتيات من أجيال جديدة لها طابع جديد، وثقافة مختلفة، يرغبون في مستقبل أفضل لكنهم لا يجدون مسارات فعّالة، فالأقرب أن نقدم لهم الدعم والسند، دعم القدرات والإمكانات لزمان ليس كزماننا.
إنّ واجبنا أن نودّع فُرقة المقهورين ونتخلص من روح القهر وآثاره، آلام المعاناة وتبعات القرارات الخاطئة، والأخطاء المتبادلة، أن نتحرر من أسر مركزية الذات والرغبة في أن نكون جميعا متشابهين متطابقين في كل شيء، ونتيجة ذلك نخسر روابطنا وعائلتنا بل ما بقي من قوتنا، ونزيد القهر قهرا والعجز عجزا.
نحتاج روحا جديدة لعائلتنا الكبيرة نتصبر فيها معا، ويرحم بها بعضنا بعضا، ويسمع خلالها بعضنا بعضا، ونجتهد في تقديم العون ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.