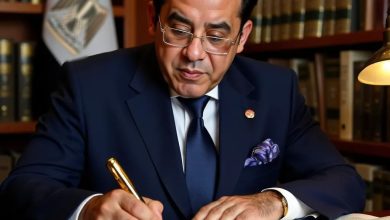لا تخلو قصّة الولايات المتّحدة مع المؤسَسات العالمية، خصوصاً المعنية منها بحفظ السلم والأمن الدوليَين، من إثارة، فحين وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، بدا العالم مذهولاً أمام حجم الدمار الذي خلّفته، ما ساعد على أن يصبح القادة أكثر قابلية للانفتاح على أفكار جديدة لإدارة العلاقات الدولية، بطريقةٍ تمنع تكرار ما حدث.
من بين أكثر الأفكار أهمّية، التي طُرحت في ذلك الوقت، إدارة العلاقات الدولية من خلال مؤسّسات دائمة تحكمها أسس وقواعد متّفق عليها، بدلاً من تركها فريسة “توازن القوى”، الذي ثبت فشله، وأدّى إلى تفاقم الصراعات في العالم.
ولأنّ الرئيس الأميركي،
وودرو ويلسون، وهو في الأصل أستاذ للعلوم السياسية، كان من أكثر قادة العالم حماسةً لإقامة منظّمة عالمية تتولّى مهمّة حفظ السلم والأمن الدوليَين، أسند إليه مُؤتمر الصلح،
المُنعقد في فرساي، رئاسة اللجنة المُكلّفة بصياغة دستور أول منظّمة دولية في تاريخ البشرية تتولّى هذه المهمّة، وهي “عصبة الأمم”. ورغم ما بذله الرئيس ويلسون من جهد هائل في تأسيس هذه المنظّمة، إلا أنّه فشل في إقناع الكونغرس بالموافقة على معاهدتها المُنشئة.
وغياب الولايات المتّحدة عن “عصبة الأمم” كان أحد أكثر الأسباب أهمّية، التي أدّت إلى فشل هذه المنظّمة في الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثانية، وبالتالي، إلى انهيارها في نهاية المطاف.
لأنّ الولايات المتّحدة هي المساهم المالي الأكبر في ميزانية هذه المؤسّسات، فعادة ما يُؤدّي إحجامها عن دفع حصّتها إلى التأثير بشدة في أنشطتها وإرباك برامجها
أسباب كثيرة تُفسّر رفض الانضمام إلى “العصبة”، أكثرها أهمّيةً خشية الولايات المتّحدة من الانغماس في النزاعات الأوروبية، وحرص الدولة الأميركية العميقة على إحكام هيمنتها، أولاً، على الأميركيتَين، اتساقاً مع مبدأ مونرو لعام 1823، قبل التطلّع إلى القيام بدور عالمي في وقتٍ كانت فيه القوى الأوروبية ما تزال مسيطرة على النظام العالمي. وعندما اضطرّت الولايات المتّحدة للمشاركة من جديد في الحرب العالمية الثانية،
كانت موازين القوى في النظام العالمي قد تغيّرت كثيراً، وهو ما يفسّر لماذا أصبحت الدول المتحالفة والمنتصرة في هذه الحرب شديدة الحرص على ضمان المشاركة الأميركية الفاعلة في إنشاء وإدارة منظومة المؤسّسات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب، ولماذا أصبحت الولايات المتّحدة نفسها حريصة،
أيضاً، ليس على المشاركة فحسب، وإنما على القيادة. لذا، لم يكن غريباً أن تنعقد معظم المؤتمرات التأسيسية لهذه المنظومة في مدن أميركية، وأن تصبح نيويورك هي المقرّ الرئيسي لمنظّمة الأمم المتّحدة، وواشنطن هي المقرّ الرئيسي للوكالات الاقتصادية المتخصّصة، التي تأسّست بموجب اتفاقيات بريتون وودز.
يثبت الفحص المتأنّي للسياسة التي انتهجتها الولايات المتّحدة تجاه المؤسّسات الدولية، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حقيقة تبدو صادمةً لكثيرين، أنّنا إزاء دولةٍ لا تؤمن بجدوى الدبلوماسية مُتعدّدة الأطراف، ولم تتحمّس، يوماً، لفكرة القيادة المشتركة أو الجماعية للنظام الدولي،
عبر تفعيل دور المنظمّات الدولية، بل يمكن القول إنّنا إزاء دولة لا تعترف أصلاً بالقانون الدولي، نظراً إلى اعتقادها أنّ القوانين الأميركية أسمى وأعلى مكانة، ومن ثمّ، لا يجوز أبداً أن تتعارض معها قوانين أو قواعد تصدرها جهات أخرى، وفي حالة حدوث مثل هذا التعارض تصبح القوانين الأميركية هي الواجبة النفاذ، والأولى بالتطبيق. لذا،
يمكن القول إنّ الإدارات الأميركية المُتعاقبة سعت إلى استخدام المؤسّسات الدولية واحدةً من أدوات سياساتها الخارجية، واعتبرتها مؤسّسات مكمّلة لوزارة الخارجية الأميركية، وهو ما يفسّر حماستها لدعم هذه المؤسّسات وتشجيعها، حين كانت أنشطتها وقراراتها تأتي متوافقةً مع سياساتها ومحقّقة لمصالحها الخاصّة. أمّا إذا حدث العكس، واتّخذت هذه المؤسّسات قراراتٍ ترى الولايات المتّحدة أنّها تمسّ مصالحها أو مصالح حلفائها،
فلم تكن تتردّد أبداً في ممارسة أنواع الضغوط كافّة عليها. ولأنّ الولايات المتّحدة هي المساهم المالي الأكبر في ميزانية هذه المؤسّسات، فعادة ما يُؤدّي إحجامها عن دفع حصّتها إلى التأثير بشدة في أنشطتها، وإرباك برامجها. وفي أحيان أخرى، لا تكتفي بممارسة الضغوط المالية، ومن ثمّ، تلجأ إلى ممارسة ضغوطٍ أشد، كالتهديد بالانسحاب من هذه المؤسّسات، وهو ما حدث مع “يونسكو” على سبيل المثال.
نمط العلاقة الخاصّة الذي يربط الولايات المتّحدة بإسرائيل، وهو نمط فريد، دفعها إلى الذهاب بعيداً في تحدّيها للمؤسّسات الدولية دفاعاً عن المصالح الخاصّة للكيان الصهيوني
قد يقول قائلٌ إنّ السلوك الأميركي في التعامل مع المؤسّسات الدولية لا يختلف كثيراً عن سلوك الدول الأخرى، خصوصاً الدول الكبرى، وهو قولٌ لا يجافي الحقيقة، من الناحية النظرية على الأقلّ. غير أنّ نمط العلاقة الخاصّة الذي يربط الولايات المتّحدة بإسرائيل،
وهو نمطٌ فريدٌ لا نظير له في تاريخ العلاقات الدولية، دفعها إلى الذهاب بعيداً في تحدّيها المؤسّسات الدولية دفاعاً عن المصالح الخاصّة للكيان الصهيوني، الذي لم يكفّ يوماً عن انتهاك قواعد القانون الدولي. وعلى سبيل المثال، عندما اتّخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1975،
قراراً يعتبر الصهيونية شكلاً من العنصرية والتمييز العنصري (القرار 3379) ثارت ثائرة الولايات المتّحدة، وفرضت على الأمم المتّحدة عقوبات شديدة ومتنوّعة، ولم يهدأ لها بال إلا عندما نجحت في حمْل الجمعية العامة على إلغاء هذا القرار في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1991، أي؛ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانفرادها بالهيمنة على النظام الدولي.
أصبحت الولايات المتّحدة أكثر الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخداماً لحقّ النقض (فيتو) بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وتشير الأرقام المُتعلّقة باستخدام الولايات المتّحدة حقّ النقض إلى أنّ الأغلبية الساحقة من المرّات التي استخدمت فيها هذا الحق، منذ انهيار الاتحاد السوفييتي،
كانت للحيلولة دون صدور قرارات من مجلس الأمن لا ترضى عنها إسرائيل، ما أدّى إلى تمكين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من إجهاض اتفاقية أوسلو (19193)، وقطع الطريق على المحاولات الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية، وأسهم بالتالي في دخول منطقة الشرق الأوسط حالةً من عدم الاستقرار الذي تعاني منه الآن بشدّة. الأخطر أنّ إدارة جو بايدن استمرّت في استخدام “الفيتو” لصالح إسرائيل،
حتَّى بعد وصول أكثر الحكومات تطرّفاً في تاريخها إلى السلطة، ورغم إقدام الحكومة الإسرائيلية الحالية على تدمير قطاع غزّة، وارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، ورفضها تنفيذ القرارات الصادرة، ليس عن مجلس الأمن فحسب، أعلى سلطة تنفيذية في العالم، ولكن عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في العالم، رغم إلزامية جميع هذه القرارات.
لا تكمن إشكالية العلاقة مع المؤسّسات الدولية في إسراف الولايات المتّحدة في استخدام حقّ النقض في مجلس الأمن فحسب، فقد كان الاتحاد السوفيتي أكثر الدول دائمة العضوية استخداما للفيتو في هذا المجلس، منذ تأسيس الأمم المتّحدة وحتَّى منتصف الستينيات،
أو في ممارسة الولايات المتّحدة ضغوطاً على المؤسّسات الدولية لحمْلها على تبنّي قرارات تصبّ في مصلحتها أو للامتناع عن إصدار قرارات تلحق الضرر بهذه المصالح، فجمّيع الدول الأعضاء في المنظّمات الدولية تمارس مثل هذه الضغوط حين تستطيع، حتَّى لو اختلفت الوسائل والأساليب. الإشكالية الحقيقية تكمن في أنّ الولايات المتّحدة ربطت نفسها عضوياً بسياسة كيان منبوذ، تديره حكومة عنصرية متطرّفة،
لا تكتفي بانتهاك القانون الدولي صباح مساء، لكنّها تسعى، في الوقت نفسه، إلى تخريب المؤسّسات الدولية، بل إلى تدميرها كلّياً إن استطاعت.
اعتمدت إدارة بايدن الرواية الإسرائيلية، وقامت على الفور بتجميد حصّتها في ميزانية “أونروا”، في محاولة مفضوحة لاتخاذ “طوفان الأقصى” ذريعةً لتدمير منظّمة دولية
فبعد أسابيع قليلة من إقدام هذا الكيان على شنّ حرب إجرامية شاملة على قطاع غزّة، ادّعى أن مجموعة من الموظفين العاملين في وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاركت مع حركة حماس في شنّ عملية طوفان الأقصى، وبدلاً من المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلّة لاستجلاء حقيقة ما حدث، اعتمدت إدارة بايدن الرواية الإسرائيلية، وجمّدت على الفور دفع حصّتها في ميزانية الوكالة الأممية،
وتبعتها دول أوربية عدّة، في محاولة مفضوحة لاتخاذ “طوفان الأقصى” ذريعةً لتدمير منظّمة دولية تخدم أكثر من ستّة ملايين فلسطيني، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى إنهاء مشكلة اللاجئين، وإجبارهم على الرحيل بعيداً من الضفّة الغربية ومن قطاع غزة،
ومن المنطقة كلّها. ورغم أنّ التقارير الأولية لتحقيقات الأمم المتّحدة تشير إلى عدم ثبوت أيّ أدلّة على صحّة الادّعاءات الإسرائيلية، إلا أنّ قرار الولايات المتّحدة تجميد مساهماتها المالية في ميزانية الوكالة ما زال سارياً. فإذا أضفنا، إلى ما تقدّم، نشر صحيفة الغارديان قبل أيام قليلة تحقيقاً مفاده بأنّ جهاز الموساد تجسّس على كبار العاملين في المحكمة الجنائية الدولية،
وسعى إلى ابتزازهم طوال السنوات العشر الماضية، لتبيّن لنا إلى أيّ مدىً وصلت العنجهية الإسرائيلية وحرص الكيان الصهيوني على التستر وراء الحماية الأميركية لتدمير المؤسّسات الدولية.
قبل تكشّف هذه الفضيحة، أدلى مسؤولون أميركيون بتصريحاتٍ تضمّنت تهديداً بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية،
بل على النائب العام نفسه، إن هم تجرّأوا على إصدار مُذكّرة اعتقال لأيّ من المسؤولين السياسيين أو العسكريين في إسرائيل، ما يدلّ بوضوح تام على وجود تنسيق مُحكمٍ بين الولايات المتّحدة وإسرائيل لتقويض دعائم المؤسّسات الدولية. فهل تنجح إسرائيل في جرّ الولايات المتّحدة إلى المشاركة معها في سياسة التدمير الممنهج لمؤسّسات النظام الدولي؟ أظنّ أنّ هذا هو بالضبط ما تسعى إليه فعلاً.