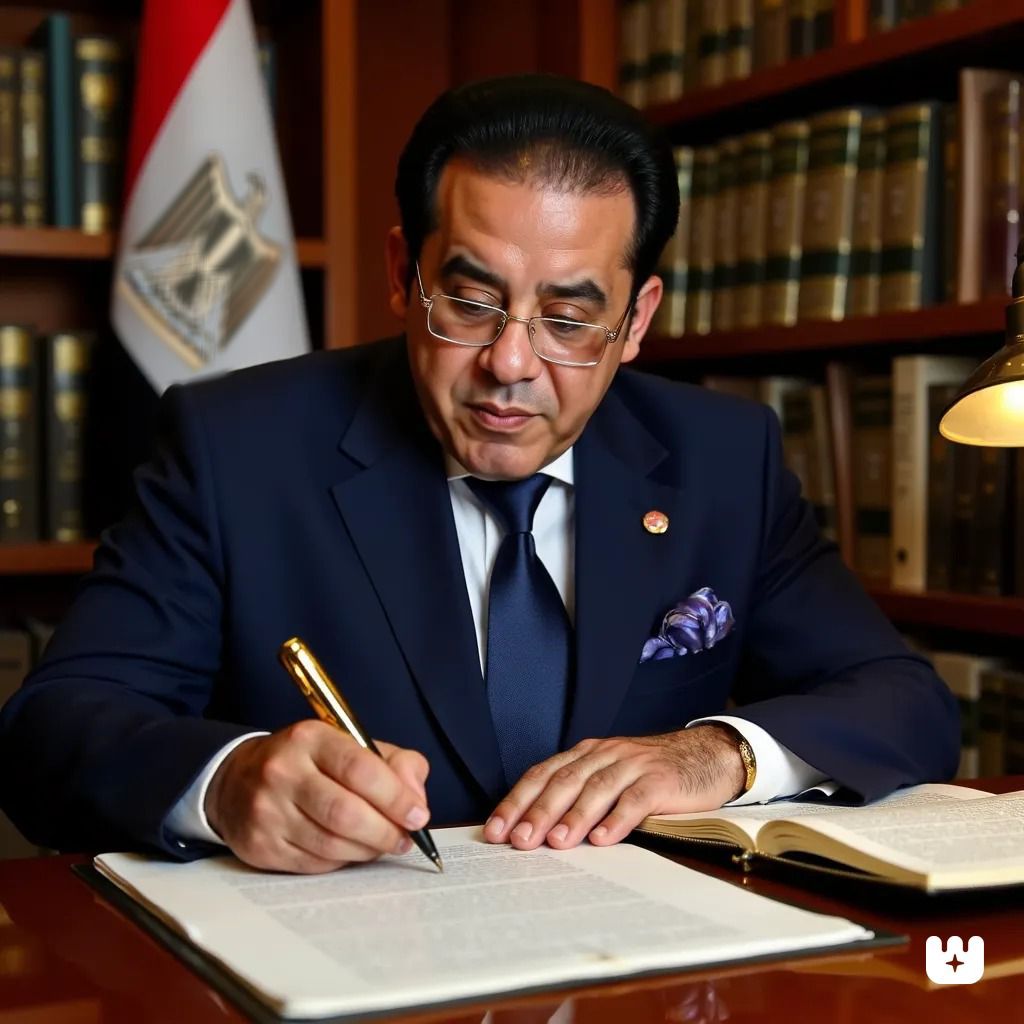
لا أحد يختار منفاه، كما يختار مكان قضاء عطلته الصيفية… المنفى لا يُستدعى… بل يُفرض، يأتيك دون استئذان، كضيفٍ ثقيل يحمل في جيبه أشياء حاولت نسيانها، ليس المنفى جغرافيا، بل هو الشعور العميق بأن وطنك لم يعُد وطنًا..صار سجنًا عموميًا، وغرفة تحقيقٍ نوافذها الضيقة تطلّ على الأسلاك.
كالبكاء، ينتابني الضحك، عندما يسألني أحدهم بدهشة – تشبه البله -: لماذا غادرت مصر؟ لم أغادر وطني… بل وطني هو الذي غادرني، ترك لي جدرانه المتصدعة، وراياته المتأرجحة بين البيع والإنكار…
ترك لي فقط نشيده الوطني، لكنه معلق على مشجب الخذلان، والفشل، والاستبداد… ورحل، ليستبدل أبناءه بملفات أمنية، وجدرانٍ صمّاء لا ترد السلام، أحطّ وأحقر إحساس إنساني ينتابك في غربة المنفى،
أن ترسل رسالة إلى شخص، ولا يرد على رسالتك…ليس لأنه لم يرها، أو لم يفهمها، بل لأنه لا يملك شجاعة الرد – ولو سرًا – وهو من يمتطي جواد الفروسية والشجاعة علنًا! فما بالك إذا كان الممتنع عن الرد هو الوطن…والوطن هو، على الأقل من وجهة نظره هو…المنفى مسكونٌ بمرارات عديدة ومتمددة، لا يسكنك وحدك، بل يسكن أسماءنا، لهجتنا، خطواتنا… حتى أوراقنا الثبوتية المحجوبة، وقلوبنا المعطوبة. فقدنا فيه القدرة على التوقيت، على الحنين، على ممارسة الحب دون استئذان أمني، يستفزني أيضًا ذلك السؤال البريء إلى حد الهطل:
هل لديك تهمة تحول دون حقك في العودة؟
في وطني، الكلمة جريمة، والنظر خلفك مرتين تهمة، نعم، في المنفى، الوطن يبدو أجمل، لكنه صورة على الجدار… لا نستطيع لمسها. وإذا فعلت، ستصعقك أبراج الكهرباء عالية القدرة، التي تسكن خلف الصورة، وتنتظرك خلف الباب. لم أعُد أحلم بوطنٍ كبير…
فقط أريد رقعةً صغيرة، لا يُلاحَق فيها الحلم، ولا يُعتقل فيها الأمل…وإن لم يكن ذلك ممكنًا…سأعيش وطنًا افتراضيًا، أمارس فيه جنسيتي ووطنيتي، دون أن يملك أحدٌ أن يسحبها مني، أعرف أنني لست وحدي، فثمة أوطان كثيرة أُقفلت في وجوه أصحابها، واستُبدلت بأجهزة تُراقب أنفاسنا، وتُصنّفنا بين “النافعين” و”الزائدين عن الحاجة”.
لكنني ما زلت أؤمن…أن المنفى قد يُصنع من الحزن فرحٌ… ومن القهر فرجٌ قريب… فالوطن يُصنع بالإيمان به، بالأصوات التي ترفض أن تصمت، حتى ولو أُسكنت في الصدى سنواتٍ طويلة…









