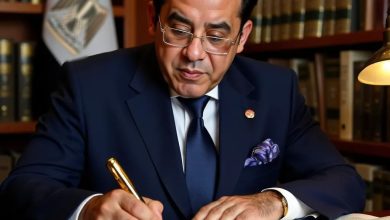غير صحيح أن الشعب المصري خاضع للديكتاتورية، وغير صحيح أنه استسلم لها، وغير صحيح أنه تكيف معها. الشعب المصري- على مدار القرنين الأخيرين- هو من الشعوب الرائدة والقائدة في كفاح البحث عن الاستقلال، والتحرر والحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة وحكم الدستور ودولة القانون.
الشعب المصري- كان وما زال- من الشعوب المتميزة خارج نطاق أوروبا الغربية في مضمار المقاومة على صعيدين متلازمين: مقاومة الهيمنة الأجنبية في الخارج، ومناضلة الطغيان المحلي في الداخل.
وبالخبرة بات المصريون على وعي أن المعركة على الصعيدين واحدة، فلا يوجد طغيان محلي، دون كفالة وضمانة ورعاية وتبادل مصالح ومنافع مع هيمنة أجنبية، منذ رعاية الروس مشروع علي بك الكبير عند الثلث الأخير من القرن الثامن عشر، أصبحت هذه قاعدة مستقرة متواترة منتظمة في السياسة المصرية المعاصرة: كل طغيان في الداخل له كفلاء رعاة في الخارج.
لهذا فإن العبء على المصريين مضاعف ومزدوج، وسوف تستمر هذه القاعدة بحكم الضرورة الاستراتيجية لموقع مصر، ووزنه المؤثر في اللعبة الدولية، حتى وهي ضعيفة لا حول لها ولا قوة، وسوف تنتهي فقط حين تقوى مناعة مصر الاقتصادية والسياسية والحضارية، ثم تتوج تلك المناعة بحكم ديمقراطي مستقر.
كثيرون يتساءلون عن اللغز المصري الراهن:
كيف كان هذا الشعب في حالة فوران على مدى عشر سنوات متواصلة في مواجهة ديكتاتورية ما قبل 25 يناير 2011م، ثم كيف انقلب هذا الشعب إلى النقيض تماماً بعد عشر سنوات من ديكتاتورية ما بعد 30 يونيو 2013 م، الشعب لم يتحول إلى النقيض، الشعب فقط تعلم الدرس، فقد دفع الثمن في 25 يناير، وما بعدها؛ ليكتشف أنه لا يوجد عن الديكتاتورية بدائل مدنية ناضجة.
وهذه المشكلة لا تزال قائمة، بل تزداد سوءا ، ديكتاتورية ما قبل 25 يناير 2011 م، كانت سياستها هي التجريف الشامل- بتعبير محمد حسنين هيكل- لقدرات الشعب الفكرية والسياسية والتنظيمية، فلم يكن لها من بديل عنها غير القوى الدينية التي استأثرت بالمجتمع لمدة أربعين عاماً، هي مجموع عهدي السادات- مبارك، ثم ديكتاتورية ما بعد 30 يونيو 2013 م، واصلت التجريف، لكن بمعدلات عالية من القسوة والشدة، وعدم الرحمة وصفر تسامح مع أي فكرة، أو شخص أو صوت أو مبادرة أو دعوة لها قيمة أو ذات معنى.
قبل 25 يناير كان ثمة بديل ديني، بعد 30 يونيو لا بدائل على الإطلاق، فلا ديني ولا مدني، لا صوت ولا همس، ديكتاتورية متشددة متزمتة، لا تسمح بخرم إبرة يمر منه ضوء، يلتمع في نهاية النفق المظلم. صناعة البدائل متعذرة في هذه الحقبة، متعذرة بحكم القوة، متعذرة بقبضة الحديد والنار، ديكتاتورية توحيدية يقينية تلقينية، واثقة ثقة مطلقة أنها على الصواب، ثم هي على الصواب الوحيد الذي لا ثاني له، وإذا وجد من يزعم أنه صواب فمكانه السجن بلا جدال.
تجريف ما قبل 25 يناير كان رحيماً
إذا قورن بقسوة التجريف فيما بعد 30 يونيو، وهو فرق بين ديكتاتوريتين، ليست أي منهما أول ديكتاتورية في تاريخنا المعاصر، ولن تكون أي منهما الديكتاتورية الأخيرة، فسوف نظل- ربما حتى نهاية هذا القرن- تتوالى علينا ديكتاتوريات، تختلف درجاتها بين الرأفة والشدة وبين الحنكة والتطرف، حتى ندرك السر.
والسر هو: البنية التحتية للديكتاتورية متجذرة في صلب الدولة المصرية الحديثة
منذ لحظة تأسيسها، بنية طغيانية تقوم على تراتب ديكتاتوري من أعلى البناء، حتى قاعدته حيث: حاكم فرد مطلق، يُحكم السيطرة التامة على عدد قليل من الرجال، ثم هذا العدد القليل من الرجال، يُحكم السيطرة على المؤسسات، ثم هذه المؤسسات تُحكم السيطرة على الشعب.
والكل في هذا الهيكل الطغياني المُحكم باشا، من قمة الحكم إلى قاعدته، من الحاكم الأعلى، حتى أصغر موظف عمومي في مجلس قروي، أو أمين شرطة في نقطة بوليس في أقصى الأرض، كلهم باشا، ويلزم أي مواطن، أن يمتثل أمامهم وفي حضرتهم، وبين أيديهم امتثال الأدنى والأضعف أمام الأقوى والأعلى.
حاول أن تختبر أحاسيسك فور خروجك من أي مصلحة حكومية- كبرت أو صغرت- فسوف تكتشف، أنك كنت منذ دخلتها، وحتى قضيت مصلحتك فيها، ثم خرجت منها كنت الطرف الأدنى الأضعف، وكانت السلطة ورموزها بما في ذلك أصغر موظفيها رتبةً، كانوا هم الأعلى والأقوى.
الشعب المصري ليس استثناءً من التاريخ
فلم يعرف التاريخ المعاصر شعباً، أنجز التحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في جولة، بما في ذلك النموذج التأسيسي في التاريخ العالمي المعاصر وهو الثورة الفرنسية.
فلم تكد تولد الديموقراطية، حتى وقعت في ديكتاتورية الثورة، أو ما عُرف بحكم الإرهاب، ثم أعقب ذلك ديكتاتورية الفرد المطلق نابليون بونابرت، ثم تحالف ديكتاتوريات أوروبا، ضد توسعية وعدوانية وغزو بونابرت، حتى سقط، ثم عادت ديكتاتورية البوربون التي كانت الثورة الفرنسية قد أسقطتها، واستغرقت الديمقراطية الفرنسية قريباً من قرن ونصف قرن، حتى نضجت على الصورة التي هي عليها في وقتنا الحاضر.
الشعوب تتخلص من الديكتاتوريات على مراحل، ثم تبني الديمقراطيات على مراحل
ولا يوجد فصل أو تفريق أو تمييز حاسم بين هذه المراحل، وربما لا يرى المعاصرون للأحداث، أنهم أنجزوا شيئاً مهما، بل العكس يكون صحيحاً في أغلب الأحوال، إذ- في الغالب- يرى المعاصرون للأحداث، أنهم قد أخفقوا في مسعاهم، وأن الديكتاتورية انتصرت عليهم، وزحفت تسترد مواقعها من جديد، وهذا- في جملته- غبر صحيح، وكما يقولون، فإن المعاصرة حجاب تحول دون الرؤية الصحيحة والتقدير السليم.
ففي نهاية المطاف، انهزمت الديكتاتورية، وانتصرت الديمقراطية، وتحرر العقل والضمير والروح الفرنسي من القيود، والأغلال التي كانت تكبله، نضجت الخبرة، واستوت التجربة، وباتت نموذجاً ملهما لكافة شعوب الأرض، حدث ذلك رغم ما توالى عليها من انتكاسات.
ورغم ما تعاقب عليها من ديكتاتوريات، لكن العنصر الحاسم هو: أن بوصلة الشعب الفرنسي كانت صحيحة، والوجهة كانت سليمة، والأخطاء لم يكن منها مفر، لأنهم يخوضون تجارب جديدة، لم يسبقهم إليها إلا الإنجليز قبل ذلك بمائة وخمسين عاما.
ثورة الانجليز بدأت عند منتصف القرن السابع عشر، ثورة الفرنسيين بدأت عند خاتمة القرن الثامن عشر، وكلا الشعبين قدم الثمن الغالي الذي به- دون سواه- تخلصت أوروبا من مزاعم الملوك، أنهم يحكمون بالحق الإلهي، وأنهم ظل الله على الأرض، وأنهم نوابه جل علاه في حكم رعاياهم من البشر، وأنهم جاؤوا بأقدار الله لا بإرادة الشعب، وأن الذي يملك حسابهم هو الله، وليس الشعب.
كان على أوروبا حتى تدشن الطريق إلى الديمقراطية
أن تجرب الثورات الشعبية، وبالذات في بريطانيا عند منتصف القرن السابع عشر، ثم في فرنسا عند خواتيم القرن الثامن عشر، جزت بريطانيا رقبة الملك تشارلز الأول في 30 يناير 1649م، ثم بعدها بما يقرب من قرن ونصف، جزت فرنسا رقبة الملك لويس السادس عشر في 10 أغسطس 1792م، خفتت نعرة التفويض الإلهي، وبدأت فكرة أن الشعوب- وليس الله- مصدر السلطة السياسية الدنيوية الأرضية مع الإيمان، أن الخالق جل في علاه له ملك السموات والأرض، طريق طويل سارت فيه الديمقراطيات الغربية، حتى نضجت، طريق طويل من زمن كانت فيه البنية التحتية للديكتاتورية هي الأصل إلى زمن، أصبحت فيه- بعد نضال على مدى قرون- البنية التحتية للديمقراطية هي الأصل.
هذه هي مشكلتنا في مصر
العيب ليس في خصال الشعب، الشعب لا ملام عليه، هذا شعب حر تواق للحياة الشريفة، بلا خنوع ولا خضوع ولا مذلة الطغيان، مشكلتنا هي، تجذر البنية التحتية للديكتاتورية، تجذرها في بنية الدولة ومؤسساتها وثقافتها وتلافيف عقلها الباطن، بنية استعلاء، بنية استغلال، بنية ازدراء للشعب، بنية استهانة بحقوق الناس، بنية تم ويتم تصميمها لخدمة مصالح تحالفات ذات هيمنة في الداخل مؤتلفة مع مصالح ذات هيمنة في الخارج، ليست مجرد ديكتاتورية عابرة، بل بنية متأصلة بقدر، ما تحققه من منافع، وتجلبه من مزايا وتحميه من امتيازات، وتخدمه من مصالح.
في هذا السياق، كل الديكتاتوريات عندنا في مصر سواء، لا فرق بين ديكتاتوريات في عهود سلالة محمد علي باشا، أو ديكتاتوريات في عهود ضباط الجيش، في ص 20 من الجزء الثاني من مذكرات الدكتور محمد حسين هيكل 1888- 1965 م، نقرأ تقييما منصفاً وعادلاً، وذا أصالة فكرية رفيعة المستوى، تقييما سياسياً لسنوات حكم الملك فاروق من توليته 1937م، حتى عزله 1952م.
يقول: “هذا العهد- أي عهد الملك فاروق- يتسم بظواهر متناقضة أشد التناقض، فلأول مرة في تاريخ مصر الحديث، تنتظم الحياة البرلمانية خمسة عشر عاماً، دون تعطل ولا انقطاع إلا في الشهور الأربعة الأخيرة (يقصد حل البرلمان الوفدي مطلع عام 1952م)
ومع ذلك، فإن هذه الحياة البرلمانية المنتظمة المتواصلة لم تمنع الطغيان، ولم تمنع الديكتاتورية المبرقعة حيناً، ولم تمنع الديكتاتورية السافرة أحياناً” انتهى الاقتباس.
مصداقية هذه الشهادة من رمز نزيه شريف عظيم في وزن الدكتور هيكل
أنها كاشفة ليس لتناقضات عصر فاروق فقط، لكن كاشفة لتناقضات الدولة الحديثة في كافة عصورها، فهي: حديثة لكن طغيانية، فيها برلمانات لكن ديكتاتورية، فيها دساتير لكن تحكمها أهواء الحكم الفردي المطلق، فيها صحافة لكن بلا حرية، وفيها قضاء لكن دون استقلال، وفيها شعارات ممتازة لكن الواقع على النقيض منها وهكذا.
المشكلة التي لم يضع دكتور هيكل يده عليها، هي أننا نتحرك صوب الديمقراطية فوق أرضية صلبة من الديكتاتورية المتجذرة في عمق الدولة والمجتمع.
وهذا موضوع مقال الأربعاء المقبل بمشيئة الله.
المصدر: (مصر 360)